القسم
مواضيع في التعليم المسيحي

مواضيع في التعليم المسيحي
الأب إيلي طوبجي
للجميع
الإنسان هو “صورة الله” ومثاله

مقدّمة:
في الحقيقة عنوان المحاضرة “من هو الإنسان” فقط، لا يُفهِم مضمون الحديث الذي أوَدُّ أن أحدثكم به. فالعنوان كما هو هكذا يوحي بأني سأتكلم عن ماهية الإنسان والغوص بتكويناته النفسية والروحية والاجتماعية والثقافية والفلسفية والاقتصادية وفي كل ما يتعلق به من العلوم الإنسانية التي تدور حول الإنسان والإنسانية لاكتشاف هذا العالم الصغير-الكبير اللامتناهي.. بينما أنا أريد أن أبتعد عن هذه العلوم والاكتفاء بنتائجها فقط والدخول في حديث الإيمان حول الإنسان ومكانه اليوم في العالم وأمام الله خالقه.
القسم الأول: الإنسان في عالمنا المعاصر
صورة الإنسان المعاصر:
إن دارسي العلوم الإنسانية من فلاسفة وعلماء اجتماع وآداب ولاهوت، يشيرون إلى أن حياة الإنسان المعاصر مطبوعة بمظاهر تميزها عن حياة الإنسان فيما سبق، وقبل الدخول في تراثنا اللاهوتي عن الإنسان سنحاول هنا أن نستطلع بعضاً من مظاهر حياة إنسان اليوم.
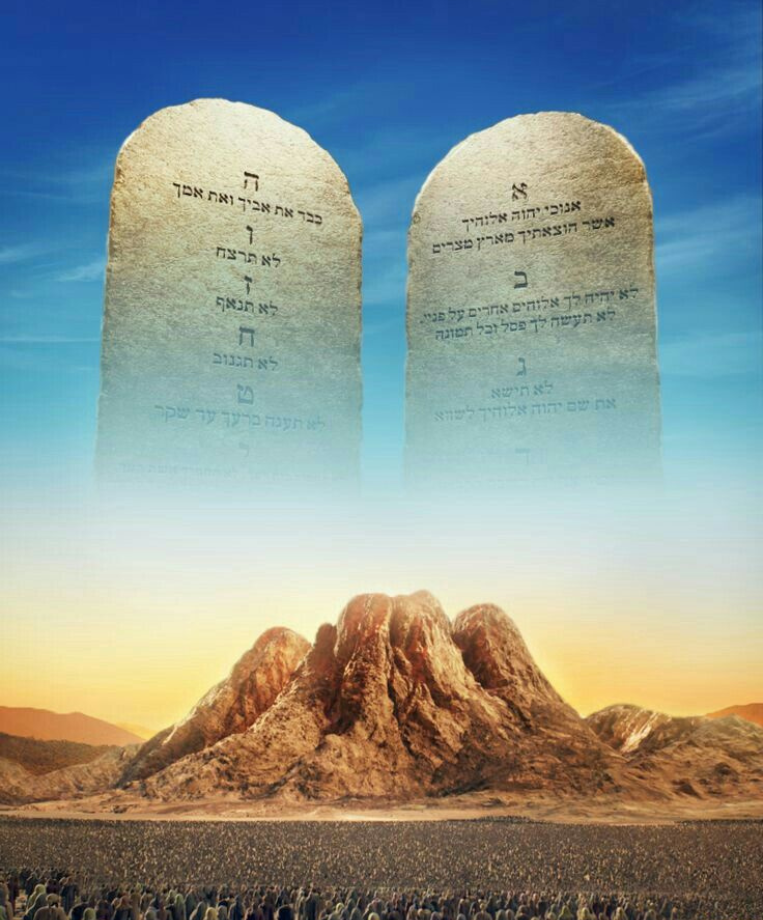
إن في الكون والطبيعة والمجتمعات البشرية نظام ثابت أبدي، هذا النظام كان سنداً مُطَمئِناً للإنسان في حياته.. لكن الإنسانية فقدت هذا السَنَد في عصرنا إذ أصبح كل شيء خاضعٌ للتغير.
فنلاحظ أن “في المضمون البشري تطور وتغير عميق وسريع. ففي الحضارة الدينية الماضية كان المعنى الروحي “مُستَلَم” مثل وديعة تعطيها الأجيال القديمة إلى الجديدة. أمّا في هذه الحضارة فالإنسان المعاصر يرى ذاته مسؤولاً ويجب عليه أن يتأكد ويعيد التفكير بشكل نقدي-نبوي في كل ما قد حققته الأجيال السابقة”. إن التغيرات كثيرة وعميقة إلى درجة أن الإنسان المعاصر خلال فترة حياته مجبر أن يعيش لوحده الخبرات التي في القديم كان يعيشها عشرين أو ثلاثين جيلاً معاً”.
هناك جفاء لأي شكل من أشكال الحقيقة والمبادئ والقواعد المطلقة. فإنسان اليوم يرفض العقائد والتقليد: فمنذ عصر الإشراق في القرن الثامن عشر وبعد، أصبح الإنسان أكثر صداً وممانعةً في قبول أي تأكيد أو حقيقة إذا لم تأتي منه أو على الأقل إذا لم يستطيع اختبارها وفهمها وذلك باختبارها هو بنفسه؛ وعنده رفض عميق لكل ما وصله من الماضي، رفض لأي شكل من أشكال التقليد. فبدلاً من فكرة التراث وَضَعَ كلمة التطور والتقدم، وبالتالي فإن “الكمال”، والنموذج الذي يسعى إليه، لا يأتيه من الماضي بل النموذج هو فيما سيكونه في المستقبل. لذلك فالإنسان المعاصر متوجه إلى المستقبل، إلى الجديد، يريد تجديد كل شيء، واضعاً بالشك ومعارضاً كل ما وصل إليه من الماضي: في حقل الدين والقانون والتربية والأخلاق والسياسة والاقتصاد.
بعد أن تخلص الإنسان من أي رباط مع الماضي ومن ثقل الحقيقة والقوانين المطلقة، يشعر الإنسان المعاصر بالتحرر بشكل كبير، وفي كل مظاهر حياته: السياسية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية، لذلك فهو بما أنه حر يطالب لذاته بحق تحقيق ذاته كما يريد، إن كان بانسجام أو بتعارض مع التقليد، والمجتمع والنظام القائم.
في بدء العصور الحديثة وضع الإنسان الله، بشكل منهجي، بعيداً عن السياسة والعلم والفن والأخلاق والقانون وشيئاً فشيئاً عن أي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية (وأصبحت الديانة قناعة شخصية). بنفس الوقت وبواسطة العلوم والتقنية اندفع لاكتشاف وغزو العالم، فاهتمامه لم يعد موجهاً نحو السماء بل نحو الأرض: إن المنظور ما فوق الأرضي اختفى من فكره وعمله وأعطى مكانه للمنظور الأرضي العالمي.

إن نتائج العلم جعلت الإنسان المعاصر يثق بالتقدم غير المحدود للبشرية. فالعلماء والبسطاء اليوم، يعتقدون أن المشاكل التي تُقلِق الإنسان ستُحَل لاحقاً أو متأخراً. فبالعلم سيصل الإنسان إلى معرفة دوماً أكبر عن المادة، وبمساعدة التقنيات سيستطيع السيطرة عليها بشكل أكمل دوماً. إن التفاؤل الذي غزا النفوس في القرن الثامن عشر مع عصر الأنوار ما زال يشد الناس حتى في عصرنا هذا. الإنسان المعاصر يشعر أنه ناضج، واعِ. فقد تعلّم أن يصنع كل شيء وحده، وأن يحكم نفسه بنفسه وأن يحل مشاكله دون الرجوع إلى أي كائن متعالِ.
في السابق عندما كان الإنسان ما زال ضعيفاً كان يلتجئ إلى الإله كي ينتصر على الجوع والمرض والبؤس والفوضى الاجتماعية، والظلم والحروب والقمع السياسي والاقتصادي… بينما اليوم يستطيع أن يحصل على نفس النتائج وأحياناً أفضل من السابق عندما يعود إلى أشخاص مثله: الطبيب والاجتماعي والمهندس والمحامي والسياسي. إنسان اليوم يرى نفسه سيداً، ليس فقط سيد اليوم ولكن سيد المستقبل أيضاً. فهو يعتني نفسه بنفسه، يبرمج ويعمل مشاريع معتمداً فقط على قوته ومصادره التي يضعها العالم بين يديه. هكذا فان الإنسان اليوم أصبح لا-متدين. وعدم التدين أصبح السلوك المسيطر في الحضارة وفي الحياة المعاصرة. لقد وُضِعَ الله بعيداً أولاً في السياسة ثم في العلم والفلسفة والأخلاق والتربية وشيئاً فشيئاً عن كل الأعمال البشرية. إن الدين غائب عن الحياة العملية وأيضاً النظرية. الإلحاد هو بدون شك السلوك المسيطر في الإنسان المعاصر.
لقد غدا الإنسان المعاصر عملياً بشكل واضح: فهو محمول نحو الفعل، عمل-إنتاج-شغل.. فالحركة هي التي تسحره وتتشربه كلياً. ولم يعد يجد وقتاً للتفكير والتأمل بل لم يعد يهمه ذلك مطلقاً. حتى عندما يفكر ويتأمل ويدرس فهذا دوماً يكون موجهاً نحو نتيجة عملية. “إن التحول من النظرية البحتة إلى نظرية العمل أمرٌ أكيد وثابت في الفكر المعاصر بشكل عام. إنه ليس فكراً تأملياً، بل فكرٌ عامل. العقل لا يتوجه ناحية الإدراك والفهم، بل يتجه إلى الإنتاج. لم يعد يجتهد ليلتقط الجوهر الثابت للواقع، بل أصبح يريد أن يعرف ليحوِّل.. الفكر المعاصر هو فكر للإنتاج والعمل.
إنه عملي: وكلمة الواقع أصبحت مرادفة للحركة. فالإنسان لم يعد يصحح أفكاره ويراجع نفسه مقارنةً مع الأفكار والحقائق الأبدية الثابتة بل أصبح يقارن أفكاره بحسب فعلها ونتائجها. “الإنسان اليوم غدا نفعياً، إنه يقبل كل ما يُعرَض عليه فقط إذا اتضحت له المنفعة والفائدة لذاته ولمجتمعه. وكل ما لا يحقق ذلك يرميه، حتى ولو كان له ماضٍ طويل أو قصير من المجد”.
الإنسان المعاصر إنسان تاريخي، إن عنده حِسّ كبير بالتاريخ فالواقع بالنسبة له هو في حركة مستمرة ولا يوجد شيء ثابت أو نهائي أو دائم، وهو يسعى إلى الاختصار دوماً أكثر. حتى أن وجوده نفسه بحالة تحول مستمر.
كان الفكر الكلاسيكي ينظر للإنسان على أنه كائن “طبيعي”، مجهز بمزايا غير متغيرة وراسخة مثل الطبيعة. أمّا الفكر المعاصر فقد رفض هذا المفهوم وأظهر الدور الجوهري الذي تلعبه التاريخية بين العناصر التي تشكل كيان الإنسان.. فالتاريخية ليست فقط من المعطيات الموضوعية، بل أصبحت بنية معارفية، شكل من أشكال فهم الواقع.
ولقد نتج عن هذا الوعي التاريخي ضرورة إعادة المناقشة والبحث في أي مذهب وحكمة أو بنية سابقة.. ومناقشة أي محاولة لتحديد ما هي الثوابت على مَرّ الزمن وما الذي يبقى في تغير مستمر.
نتيجة لما سبق، يقف الإنسان المعاصر ضد كل العلوم المجردة والمبادئ الميتافيزيقية (الميتافيزيقيا علم ما وراء الطبيعة، شعبة من الفلسفة تشمل علم الوجود وعلم أصل الكون وتكوينه). فبعد أن أزاح كانطKant الميتافيزيقيا من الفكر النظري وكومط Comte ربطها بفترة الإنسانية التي كانت قاصراً، وأيضا منذ أن استطاع العلم الحصول على شرح وحل للمشاكل التي كانت سابقاً تختبئ خلف علم ما وراء الطبيعة، لم يعد الإنسان يرى علم الميتافيزيقيا علم العلوم بل أهملها وأنكرها ووضع نفسه بين أيدي العلم ووضع ذاته في خدمته.
الإنسان المعاصر ينظر فقط إلى النتائج: إنه واقعي، وعملي. والعلم ونتائجه الذائعة بهرته وسلبته. بينما الميتافيزيقيا بالعكس، لا يمكنها أن تعطي نتائج، ولا تُنتِج أشياء للاستهلاك، ولا تضمن رخاء العيش. لذلك فهو يَعتبر أنها معرفة لا أهمية لها. وحتى لا يمكنها أن تكون مسلية، لأنها مليئة بأشياء غامضة وغير مفهومة..
إن انسياق الإنسان بالتطور التقني والعلمي ورخاء العيش دوماً نحو الأفضل، أَوصَلَه إلى نظرة ثقة وتفاؤل بالمستقبل. فهو واثقٌ من نفسه لأنه: يملك تقنيات في تحسن واكتمال دائم، وقد تعلّم استغلال موارد الطبيعة بشكل أكثر فعالية وبتطور دائم، وأصبح يستطيع التحكم بمجرى التاريخ. فإنسان اليوم يضع مشاريع كبيرة وطموحة للمستقبل؛ إنه يهدف إلى تحقيق غايات كبيرة في مجتمعه حيث لن يعود هناك بؤس ولا ظلم ولا جهل ولا مرض ولا عنصرية ولا أفضليات بل سيكون هناك مجتمع كامل سيجعل الجميع فرحين كلياً وسعداء.
إن الإنسان المعاصر أصبح ضائعاً وغير مطمئناً. لقد أضاع كل مبدأ ثابت يستعين به على توجيه ذاته ولم يعد باستطاعته أن يُوجِدَ قيم قياسية يؤسس عليها أحكامه. فلم يعد يعرف أن يفرّق بين الخير والشر، بين الحق والزيف، بين الجمال والبشاعة، بين النزاهة والخِسَّة، بين المفيد والمؤذي، بين المسموح والمحظور، بين الاحتشام والخلاعة.. الخ. لم يعد متأكداً من أي شيء؛ ليس لديه أي مركز ثابت يستند اليه، يعيش كما المعلق في الهواء. فالأمور الأكيدة القديمة في ثقافته وآدابه قد انهارت؛ والقيم التي تأسست عليها حضارتنا قد تفتتت واضمحلت؛ والمرجعيات اللازمة للتطور والعمل فقدت أهميتها.
وحتى المسيحيين أصيبوا بهذا الضياع، “الأزمة التي يمر بها العالم المسيحي اليوم هي أزمة يقين. فالقلق والاضطراب والضياع الذي أصابه نَتَجَ من تكاثر وانتشار أفكار وفرضيات جديدة في حقل اللاهوت، وتفسير الكتاب المقدس والأخلاق، كثير من المسيحيين رأوا انهيار كل الثوابت القديمة ودخلوا في نفق مظلم، كل شيء فيه غير أكيد. فلم يعودوا يشعرون بأنهم متأكدين من أي شيء، ولا حتى من الحقائق الأساسية في الإيمان والأخلاق”.
إن الإنسان المعاصر غدا عبداً لميوله: الأنانية، اللذة، الحسد، الشهوات الحسية، الكذب، الجشع، النصب. ولكي يرضي ميوله الكثيرة فهو يستخدم أي واسطة. لا يهمه كثيراً إذا كان يتسبب بتخريب الجمال الطبيعي، أو إهانة الآخرين، أو الإضرار بحقهم، وقد تصل الأذية إلى حد حرمانهم حقهم الأساسي في الوجود. فالمهم أن تنتصر اللذة والرفاهية.
إن المجتمع الاستهلاكي يُدرِّب ويُحرِّض دوافع الأنانية، والإثارة الجنسية، والتكبر، والعنف.. بينما لا نرى تشجيعاً للقيم الأخلاقية والروحية التي تحافظ على صحة المجتمع. هكذا فالإنسان المعاصر، بدلا من أن يتطور نحو الأعلى، يغوص دوماً إلى الأسفل، ويصبح دوماً أكثر انحرافاً، إنه فاسد الأخلاق ويجد نفسه غارقاً في بحر من الانحراف.
وتتضح، أخيراً، على الإنسان المعاصر ملامح الخيبة، والكآبة واليأس. فالمفكرون والأدباء والفلاسفة واللاهوتيون يجمعون على أن واحداً من ملامح إنسان العصر هو الكآبة.
تندرج أيضاً صعوبات مجتمعنا الشرقي المسيحي في العالم العربي تحت هذه النقاط العامة الموجودة في المجتمعات المعاصرة. فمن البيان الختامي للمؤتمر الأول للبطاركة والأساقفة الكاثوليك في الشرق الأوسط الذي انعقد في أيار 1999 نفهم بعض الأمور:
توجهات الإنسان المعاصر:
من هذه المظاهر التي استعرضناها والتي تميز حياة الإنسان المعاصر، نكتشف أن الإنسان اليوم أكثر مما سبق، يتخطى وضعه الذاتيAutotranscendance ويريد أن يرتفع بذاته دوماً نحو الأمام، نحو الأكثر، ونحو الأفضل فهو في حالة تغير وتحول مستمر. ولقد توقف الفلاسفة والمفكرين طويلاً عند هذا الميل في الإنسان، وهذه النزعة تمثل إنسانيته الناضجة، فمن الفلاسفة مَن رأى أن الإنسان يتخطى وضعه الذاتي ليحقق ذاته بشكل أكمل، ومنهم من رأى أن الإنسان يتخطى وضعه الذاتي ليحقق مجتمعاً أكمل، ومنهم من رأى في تخطي الإنسان لوضعه الذاتي انشدادٌ وتحقيق لذاته الإنسانية في الله.. وسنعالج هذه النقاط فيما يلي:
قلنا إن الطبيعة الإنسانية العاقلة تتميز بتخطي الذات، فالإنسان مشدود نحو تحرير نفسه من عبودية الجهل، والخطأ، والخوف، والميول. لكن هذا الجهد لتخطي الذات لا يعني أنه خروج من الذات وتحول إلى شخص آخر. فإن دافع الإنسان لتخطي ذاته يحدو الإنسان للحصول على وجود أكثر حقيقية، وليصل إلى تحقيق أغنى وأكمل لذاته ولإمكانياته.
فالإنسان يحاول الحصول على مستوى أفضل من المعرفة، ومن الثقافة الحضارية، والرفاهية، لكن دون أن يرمي في البحر ما كان يعرفه وتعلمه، وما يستطيع فعله وما يمتلكه. إن تخطي الذات ليست تضحية بالنفس لكي نربح شيئاً آخر: إنها بالأحرى وقبل كل شيء بحثٌ لأجل شخصية أكثر كمالاً.
إن المفكرين الوجوديين أمثال نيتشهNietzsche وسارترSartre وهيدغرHeidegger، يقولون إن الإنسان يستطيع تخطي ذاته بقواه الذاتية فقط. لكن الخبرة تعلمنا أن محاولاتنا تُحبَط في أكثر الأحيان: فإننا لا نحوز العلم، ولا التملك، والسلطة، ولا ما نرغب به. وإن تخطي الذات كهدف بحد ذاته دون وجود غاية تُوَجِّهُهُ وتَسمو به هي محاولة لا معقولة ولا جدوى منها لأنها تصب في الفراغ..
كثير من المؤلفين بعد ماركس Marx وكومط Comte رأوا أن تخطي الذات حركة لتخطي حدود الفردية والأنانية ومحاولة لخلق إنسانية جديدة متحررة من البؤس الفردي والتفاوت الاجتماعي، وهذا هو الشرط لتحقيق السعادة الكاملة.
ماركوسMarcuse يقول إن تعالي وتطور إنسان هذا العصر يكون بسعيه إلى: المعرفة، العلم، التقنية والعملية؛ وهو مثل غاروديGaraudy الذي يؤكد أن نضوج الإنسان ذو طابع تاريخي وزمني بحت ولا يكون على المستوى الميتافيزيقي (الفائق الطبيعة): إنه الاندفاع نحو مستقبل المجتمع الأفضل من المجتمع الحالي.
أمّا بلوكBloch فيعتقد أن تخطي الذات نابع من أن الإنسان يسعى إلى “ما ليس بعد”، هذا المدى من الإمكانيات الذي يجده الإنسان أمامه. والأمل هو أن يحقق الإنسان إمكانياته التي ليست محققة بعد وهو أمرٌ بشري بحت ولا علاقة لله بالأمر.
إن ما يحمله هذا التفسير من حقيقة هي أن حركة تخطي الذات لها أيضاً بعد اجتماعي: فالإنسان ككائن اجتماعي ينمو. ومن ناحية أخرى فإن هذه النظرية بتخطي الذات على المستوى الاجتماعي تواجه اعتراضات كثيرة نابعة من تنظيم المجتمع مهما كان نوعه: اشتراكياً كان أم رأسمالياً.
فما لاحظناه من حركة تخطي الذات يتضمن البعدين الفردي والاجتماعي ولهذا السبب فإن ماركسMarx واتباعه الذين يقفون فقط عند البعد الاجتماعي، يعطون تفسيراً لتخطي الذات لا يمكن قبوله لأننا حتى ولو فرضنا أن الإنسانية من خلال تطورها البطيء ستصل إلى تحقيق ذاتها كاملة ولن يبقى هناك احتياجات ناقصة وسيكون تساوٍ بين الناس فإن ذلك لن يحلّ المعضلة الفردية ومتطلبات الإنسان الحالية.
وفي الحقيقة لن يستطيع الإنسان أن يعطي معنى لوجوده إذا وضع ثقته بعناصر كونية، فإن كل ظواهر العالم لها وقت وتنتهي فيه. ولن يستطيع الإنسان أيضاً أن يعطي معنى لوجوده إذا وضع ثقته بالإنسان الآخر لأنه هو أيضاً محدود وزائل. ولذلك على الإنسان أن يبحث في منحى آخر ليجد المعنى الحقيقي لتخطي ذاته ولمعرفة معنى وجوده.
كثير من الباحثين يعطون لتخطي الذات هدف ومعنى إلهي: فالإنسان مدفوع من داخله باستمرار ليتخطى ذاته ويتخطى حدود واقعه، لأنه مدفوع من قِبَل إرادة أعلى منه ليفعل ذلك، وهذه الإرادة هي الله. فالله بسخائه وطيبته وكماله وحضوره في كل مكان، يوجه نحوه كل الخلائق وخصوصاً الإنسان.
يَظهر الإنسان للاّهوتي كارل راهنرRahner ككائنٌ منفتح في جوهره، ولا ينغلق على ذاته أبداً ويقف عند “النهاية”. وفي هذه الانفتاح غير المتناهي يكمن تخطي الذات: فهو يجعل الإنسان منطلقاً دوماً نحو الأمام. لكن هذا لا يُقصد به انفتاحه نحو الفراغ، مثلما يجزم معلمه هيدغرHeidegger، ولا هو انفتاح موجَّه نحو مستقبل لن يصبح واقعاً أبداً، كما تخيل غاروديGaraudy وبلوكBloch، بل هو انفتاح يصبّ في المطلق، هذا المطلق الذي يكون لانفتاح الإنسان كالختم الوحيد القادر على إغلاقه وتماسكه. إن التفسير المتمحور في الإله لحركة تعالي الإنسان على ذاته فيه الإجابة النهائية لبحث الإنسان عن المعنى الجوهري والحقيقي لانشداده وتعاليه بشكل متواصل، لأن هذه الحركة تقود الإنسان نحو الذي هو أساس كل معنى وكل قيمة، إنه الله.
بما أن التفسير المتمحور في الإله لتعالي الإنسان يحدد معنى تعاليه في الله، فقد ظهرت ضد هذا التفسير صعوبة كبيرة وهي: إن هذا التفسير ينفي واقعية الله ككائن موجود لأنه تأكيدٌ منطلقٌ من الذات. فاليوم يوجد فلاسفة يؤكدون أن من غير الممكن معرفة الله ولا يمكن برهنة وجوده اطلاقاً، ويقولون إن فكرة الإله بالتالي هي فقط تشخيص لاحتياجات وخيالات الإنسان السامية: وبمعنى آخر، إن الله اختراعٌ من فكر الإنسان.
رداً على هذا يكرر اللاهوتيون أن جوابهم على حركة تعالي الإنسان لذاته نحو الله لا تفترض أنها تريد أن تبرهن وجود الله في الأصل، ولكن مع ذلك فإن حركة تعالي الإنسان هذه نحو الله هي نفسها تبرهن وتعطينا وثيقة أكيدة لواقعية الله. فإن تخطي الإنسان لذاته هي حركة وبالتالي فان أي حركة تفترض غاية وهدفاً. وبما أننا وجدنا سابقاً أن لا الأنا ولا الإنسانية يستطيعان إعطاء معنى لهذه الحركة، فلا يبقى احتمال آخر إذاً إلا الاعتراف بأن المعنى الأخير لتعالي الذات الإنسانية، وبالتالي المعنى الأخير للإنسان، موجود خارج الإنسان نفسه وهو موجود في الله، بل هو الله. لأن الإنسان لا يخرج من حدود وجوده الشخصي لكي يغوص في اللاشيء، بل يخرج من ذاته لكي يلقي بنفسه في الله، الذي هو الكائن الوحيد الذي يستطيع حمل الإنسان إلى الكمال وتحقيق ذاته الدائم.
كما يُخطئ فلاسفة كثيرون إذ يجعلون حركة تخطي الإنسان لذاته الأفقية (أي البعد التاريخي) تعارض حركة تخطيه لذاته العمودية (أي الميتافيزيقية)، كما لو أن الأمر يتعلق بتوتر متعاكس، بينما هو بالأحرى انسجام، لان حركة التعالي الأفقي تأخذ معنى وواقعية فقط من التعالي العمودي، وإلا لأصبح الإنسان أداة لا جوهر له.
وبالنسبة للمفكر المسيحي، فإن إلحاح الفلسفة على أن تخطي الذات الأفقي يتقوى ويتدعّم ويتلازم مع الحركة العمودية، يجد أفضل تأكيد له على المستوى التاريخي في الوحي الإلهي. والوحي يعلّمنا أن الله، رغم سقطاتنا، وذنوبنا، وبرودتنا، ومقاومتنا له، بقي يريد أن يشفي غليلنا في طموحنا لنكون مثله، فأدمجنا في حياته الإلهية ذاتها، بشكل غامض في هذه الحياة الحاضرة، لكن في وضوح ساطع بالرؤيا الإلهية في الحياة المستقبلية.
باختصار نقول إن المسيحي يعرف بالتأكيد أن المعنى الحقيقي والنهائي للإنسان هو الله نفسه، وهذا التأكيد ليس متعاكسٌ بل هو منسجمٌ بشكل تام مع التطلعات البعيدة النظر للعقل البشري، إن هذا التأكيد يجده في ذاته نفسها إذا فهم المعنى العميق الموجود فيها للخبرة المنتشرة في كل مكان عن تخطي الذات وتعالي الإنسان في مجالات الحياة كافةً.
القسم الثاني: الفكر الكتابي والمسيحي حول الإنسان
رأينا في القسم الأول أن المعنى الحقيقي لذات الإنسان وكماله البشري يجده في الله فقط. وهذا ما يُعلِّمه الكتاب المقدس ومن بعده المفكرين المسيحيين معتمدين تعليم الوحي الإلهي بأن الإنسان هو “صورة الله” ومثاله. وهذا هو تعليم الإيمان الأساسي حول الإنسان.
وبما أن موضوعنا لاهوتي، فسأبدأ بتعريف بسيط لعلم اللاهوت. إن علم اللاهوت يعتمد على مبدأين: الأول هو معطيات الوحي الإلهي في الكتاب المقدس، والثاني هو المبادئ الفلسفية التي يعتمدها اللاهوتي ليبني عليها فَهمه وشرحه وتعليمه لتاريخ الله الخلاصي، وإن اختلاف المبادئ الفلسفية التي يعتمدها اللاهوتي ستؤدي حتماً إلى اختلاف في النتائج والتعليم، وهكذا يُخلق التباين وأحياناً التشويش فيما بين اللاهوتيين وتعاليمهم المختلفة. لكن ومن ناحية أخرى إن هذه هي الطريق الوحيدة لتطور علم اللاهوت الذي يحاول في كل عصر أن يعيد شرح الإيمان المسيحي وعقائده لأبناء كل عصر وبحسب تطور مفاهيمهم الفكرية والعلمية.
في هذا القسم الثاني من حديثنا سنبدأ بعرض معطيات الكتاب المقدس المتعلقة بموضوعنا، ثم سنكتشف تعليم الآباء اليونان والسريان من خلال تعليم غريغوريوس النيسي ومار أفرام، بعد عرض المبادئ الفلسفية التي اعتمدها آباء الكنيسة في الشرق ليبنوا عليها اللاهوت الذي مازالت كنائسنا تعيش منه. وهو في نفس الوقت جواب كنائسنا عن تساؤل الإنسان ويمكن أن يكون جواباً ممكناً حتى في عصرنا اليوم للمسيحي المؤمن.
الكتاب المقدس:
إن التعليم حول الإنسان كـ “صورة الله” ومثاله، يعتبر المرتكز الرئيسي لفهم الإنسان في العهد القديم. وهذا مُستَنِدٌ إلى الآيات الموجودة في سفر التكوين 1/26-27 بشكل خاص وفي سفر الحكمة 2/23 وسفر يشوع بن سيراخ 17/3، وعلى هذه الآيات المشهورة أسس الآباء والمدرسيون بعدهم تعليمهم حول الإنسان “صورة الله”. وسنشرح فيما يلي معناها.
جاء في سفر التكوين 1/26-27: “وقال الله: “لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على أسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض”. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم.”
من تعبير “صورة الله” نفهم شيئان: الأول، إن للإنسان مكانة هامة في الخليقة لأنه قمة الخلق، فالإنسان كامل في خلقه إلى درجة شبهه بالله خالقه. والثاني، دور ووظيفة الإنسان كممثل لله في الكون وكـ “نائب” عنه في الخلق، فلقد أُعطيت له مهمة حكم الخليقة.

إن الكاتب الملهم لا يريد أن يحدد بالضبط في أي شيء يكمن شبه الإنسان بالله، إذا كان في التفكير أو في الكلام، في الإرادة أو في العمل، في الروح أو في الجسد.. إنما من مجمل العهد القديم، (والمعروف انه يمنع أي تمثيل بشري للإله بصورة أو بتمثال)، لا نظن أنه يقصد بالإنسان “صورة الله” كتمثيل مادي مباشر عن الله. ونوضح: “إن تشبيه الإنسان بالله يفصله عن كل الخلائق دونه ويضعه من ناحية الإله ومعه ينتميان إلى عالم أسمى. وبنفس الوقت يفصله بشكل جوهري عن الله، فإن تعالي الإنسان المطلق على الخليقة يتضح من أنه لا يبدو “طفلاً” أو “ابناً”، لكن كـ “صورة”. فليس لديه طبيعة مساوية للإله، إنما هي شبيهة بها”.
لذلك رأى البعض أن شبه الإنسان بالله آتٍ من “مظهره المستقيم”، والبعض الآخر يقول بأنه شبيه له في إمكانية التفاهم المتبادل الذي يبدو من التعبير الرمزي في خلق البشر بين الذكر والأنثى، وبالنسبة لأكثر المفسرين القدماء والحديثين فإن شبه الإنسان بالله آتٍ من قدرة الإنسان على التصرف كإله، فالله يخلق وينظم العالم، والإنسان يستثمر العالم ويحكمه. فالشبه إذاً لا يتركز في المستوى الجوهري لكن الديناميكي، أي لا يتركز في الوجود إنما في التصرف والعمل.
إن موضوع الخلق بالنسبة لشعب العهد القديم موضوعٌ أساسي ويعتبر موضوع الإنسان “صورة الله” واحدٌ من قواعد الأخلاق في العهد القديم، فإن “صورة الله” تتكرر في الشخص وفي كل إنسان (تك 1/26-27؛ 9/6)، حتى ولو أن نصيبه كان هامشياً: فإن كل البشر يجب أن يرتبطوا ببعضهم من خلال أخوّة عالمية واحدة (مي 4/3-4؛ اش 2؛ 19/24ت).
وينتج بديهياً من هذه القاعدة مبدأ أخلاقي وهو: احترام الفرد، “صورة الله”. لذلك يجب أن تحترم حياة كل فرد إلى أقصى حد (تك 9/6) كما أن كل فرد مسؤول عن الأخلاق إلى أقصى حد، حيث على قايين أن يجيب على ما فعل بأخيه (تك 4/9-12)، وداود يعاقَب لأجل خطاياه (2صم 12) وكل واحد مضطر أن يحب القريب مثل نفسه (أح 19/18).
وجاء في سفر الحكمة 2/23: “فإن الله خلق الإنسان لعدم الفساد، وجعله صورة ذاته الإلهية، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم، فيختبره الذين هم من حزبه.”
في هذا المقطع نرى تطور في فهم معنى سفر التكوين، إذ يؤكد أن “صورة الله” لم تُدمّرها خطيئة الأبوَين الأولَين. كما نرى أيضاً توجه كاتب سفر الحكمة وتأكيده أن الله خلق الإنسان خالداً لا يموت، لذلك فهو صورة لطبيعته. “سفر الحكمة يدلنا أن المظهر الأهم لـ “صورة الله” هو أن الإنسان يشبه الله بعدم الموت”. مع سفر الحكمة نرى بداية تأثير التفكير الفلسفي إذ انتقل التفكير في شبه الإنسان لله من المستوى الديناميكي إلى المستوى الجوهري.
نظرية تألُّه الإنسان حسب أفلاطون (427 ق.م.-353 ق.م.):
يقول هـ. مِركي H. Merki: “لا شك أن نظرية تألُّه الإنسان عند أفلاطون تعتبر واحدة من أهم تعاليمه الباقية ليس فقط في المدرسة الأفلاطونية، ولكنها دخلت أيضاً في أنظمة فلسفية أخرى، فغدت مثل إناء يمتلئ قليلاً فقليلاً كل مرة تستخدمها واحدة من التوجهات الفلسفية المتنوعة. ولقد دامت أيضاً في تعليم آباء الكنيسة وحتى إلى ما بعد”.
لكي نفهم تطور فكر آباء الكنيسة حول “صورة الله” سنحاول توضيح النقاط الأكثر تعبيراً لنظرية أفلاطون في تأليه الإنسان وهما نقطتان: الأولى تتعلق بالنظام الجوهري والثانية تتعلق بالنظام الأخلاقي.
أمّا ما يتعلق بالنظام الجوهري فإن تعليم أفلاطون حول التأليه أو “شَبَه الله”، نجده في نظريته عن الأفكار. لقد فهم أفلاطون الأفكار أمثلةً إلهية؛ إنها المبادئ والنماذج الأصلية، لأي حقائق كونية مادية، فالحقائق المادية تعتبر نُسَخ غير كاملة، أي صور عن الأفكار. إذ يقول: “إن الأفكار نماذج ثابتة في جوهرها؛ بينما الأشياء تشبه الأفكار وهي نسخ عنها”. أمّا الإنسان في نظر أفلاطون فلا يخضع لهذا المبدأ الميتافيزيقي، أي أنه ليس نسخة عن الأفكار الإلهية لأنه في جوهره نفس. وبفضل طبيعته الروحية تنعم النفس بتشابه مع عالم الأفكار: إنها في الحقيقة “من نفس نوع الأفكار”. بالتالي إن النفس تنتسب إلى العالم الإلهي بدليل طبيعتها.
وعلى هذا الأساس يبني أفلاطون كل تعليمه الأخلاقي حول “صورة الله”. فهو يعلّم أن غاية حياة الإنسان الأخيرة هي الخلود والذي يحوز عليه بواسطة الولادة، وهي على ثلاثة أنواع: طبيعية (من خلال الأبناء)، فنية (في الأعمال الفنية)، ولادة روحية (من خلال الفلسفة). بالتأمل الفلسفي يعي الإنسان أصله الإلهي وتصرفاته تكون نتيجة لذلك، فعليه أن يعمل ويتصرف بإلهام من عالم الأفكار الإلهي؛ وهكذا بتصرفه الإلهي، يستطيع أن يسترجع شبهه بالله. ولكي يشرح هذه المواضيع يستعمل تعابير متنوعة. أحياناً يقول بشكل واضح بـ “تقليد الإله” و “مشاركة في الحياة الإلهية”. ففي كتابه تيتِتو Teeteto يقول: “أمر واحد يناسب الإنسان: وهو محاولة الهرب من هذا المكان إلى ذلك الآخر، بأسرع ما يمكنه. والهرب يكون بتمثل الإله وأن يصبح بارّاً وقديساً، مستعيناً برؤية عقلية روحية”.
الله بالنسبة لأفلاطون سرّ كبير. إذ يقول في كتابه طيميو Timeo: “من الصعب إيجاد الأب الصانع الكون، وإذا وجدته فمن الصعب الكلام عنه”. إن أفلاطون يطابق أحياناً الله مع واحدة من الأفكار الأساسية (الجيد، الجميل، الوحدة، الوجود)؛ فما يقوله عن هذه الأفكار يتوافق تماماً مع المفهوم الديني لله. وفي مرات أخرى يُبعد الله من هذه المطابقة، معطياً لله حيوية، وواقعية، وديناميكية، وعملية لا ينسبها إلى الأفكار أبداً… أمّا الذي يهم الإنسان فهو أن يعود إلى العالم الإلهي الذي نزل منه والذي ينتمي إليه بحسب طبيعته. ولذلك نفهم قصد أفلاطون عند حديثه عن التألّه، إذ يقول بشكل متواتر بتقليد الأفكار. في كتابه الجمهورية يقول: “مَن يملك قوة التأمل المرفوعة حقاً نحو الأفكار، لا وقت عنده ولا حتى للنظر إلى الأسفل، إلى ضجة وضوضاء الناس. وهو لا يستطيع أن يجابه الناس، ذوي النفوس المنفوخة بالحسد وبالمشاعر الحاقدة؛ بينما نظره هو متجهٌ إلى عالمٍ عناصره خالدة وثابتة في هويتها؛ إنه يتأمل وجودها الذي لا يعرف الإساءة؛ كل شيء منظّم هناك وله السلطة على العقل. هذه هي النماذج التي يريد أن يتلاءم معها بأسرع ما يمكنه”.
يتّضح من هذا كله أن الإنسان يبلغ تحقيق ذاته كاملاً بواسطة التألّه، أي بتقليد الإله، وبالاشتراك في الحياة الإلهية. وبهذا التعليم أثّر أفلاطون تأثيراً ثابتاً وحاسماً، في المدارس الفلسفية اليونانية أولا وفي آباء الكنيسة ثانياً.
الإنسان “صورة الله” بحسب غريغوريوس النيسي (329-390):
إن تعليم الإنسان “صورة الله” هو المفتاح الأساسي لفهم آباء الكنيسة الذين حاولوا أن يوضحوا كيان الإنسان وجوهره. وهنا نقف عند غريغوريوس النيسي كممثل للفكر الشرقي اليوناني نظراً لأهميته وتأثيره.
يوضح غريغوريوس أولا معنى تعبير “صورة”. فالصورة هي إعادةُ تشكيلٍ أمين ومتكامل للنموذج ولذلك فهي تعني الشَبَه الأكيد له، ولكنها بنفس الوقت ليست نفسه. الصورة هي صورةٌ حقاً لأنها تمتلك كل صفات النموذج. وإذا لم تكن الصورة صحيحة، فهي ليست صورة بل أي شيء آخر.
بتطبيق هذه المفاهيم على “صورة الله”، يرى غريغوريوس أنه إذا كان الله هو كل ما هو صالح، فالإنسان بما أنه “صورة الله” هو أيضاً ممتلئ صلاحاً: “لذلك يوجد فينا التعبير لكل ما هو شريف، لأيّة فضيلة ومعرفة وكل ما نستطيع معرفته بقوة عقلنا”. لكن بما أن الإنسان ليس الله نفسه إنما صورة له، يبقى هناك اختلاف جذري فيما بينهما لأن الله كائنٌ قائم بذاته، غير مخلوق، بينما الإنسان “صورة الله”، يأخذ وجوده بالخلق.

ومتابعاً لأفكار من سبقه في موضوع الخلق، فإن غريغوريوس يقول بأن هناك خليقتين، أول خليقة هي “صورة الله”، والثانية هي الخليقة الواقعية التاريخية. فبمجرد أن قرر الله خَلْق الإنسان، خَلَقَ “صورة الله” المثالية. وهذه الصورة المثالية تنطبق على الإنسانية كلها. إن شَبَه الإنسان لله موجودٌ في النفس أكثر منه في الجسد. فكل صفات النفس الأساسية (روحية، حرية، خلود) تجعلها شَبَه الله. فإن “في الطبيعة الإلهية يوجد العقل والكلمة. وهي موجودة فيك أيضاً فإنك تنتبه إلى أنك تمتلك الكلمة والقدرة على المعرفة، وهما طبعاً صورة لذلك العقل وتلك الكلمة”. ثم الحرية، وهي ليست فقط توضيحٌ لذات الإنسان بل هي أيضا سيادة الإنسان على الأشياء في الكون. يؤكد غريغوريوس أن الله خلق الإنسان شبيهاً له لأنه أراد أن يهيئه مسبقاً للسلطة التي سيمارسها على الكائنات الأخرى. وهكذا فإن سلطة الإنسان على الكائنات الأدنى هي أوضح إظهار لشبهه بالله. أخيرا، إن “صورة الله” تتضح بالخلود، فهي مثل الله لن تفنى أبداً.
يوضح غريغوريوس أيضاً أن هناك شَبَه لله في الجسد. أولها وضعية الإنسان القائمة، وهي علامة تعبر عن سموه. وأيضاً يد الإنسان، حرة لأجل تشكيل الأشياء، وخفيفة الحركة لتنفذ ما في الفكر، أيضاً وجود أعضاء النطق للفظ الكلام، والحواس للإدراك الحسي للأشياء، والوجه الذي يعكس الروح. الجسد هو “صورة الله” بشكل غير مباشر، بما أنه يعكس شعاعات جمال الروح وبما أنه أداة للأعمال العضلية والفكرية ولأجل ممارسة سلطته.
بعد أن شرح غريغوريوس “صورة الله” المثالية يعود ليشرح “صورة الله” الواقعية والتاريخية. فهذه وضعها الله عندما قرر أن يخلق الإنسان بجنسين. فعندما أعطى الله الجنس للإنسان جعله مماثلاً للحيوانات. هكذا في “صورة الله” الواقعية فإن الشَبَه يتجه في منحيين: نحو الله بواسطة الروح وإمكانياتها، ونحو الحيوانات بواسطة الجسد والجنس. “إن الإنسان موجود في الوسط، بين واقعين متناقضين، بين الطبيعة الإلهية التي لا تموت، والطبيعة الحيوانية غير العاقلة. من الطبيعة الإلهية المعفاة من التمييز الجنسي تنشأ قوة العقل والفكر في الإنسان؛ بينما من الطبيعة الحيوانية، المعفاة من العقل، فهو يعيش التنظيم الجسدي والتمييز الجنسي”. إن الحياة الإنسانية تدور في صراع مستمر بين هذين الاتجاهين، وبالطبع فإن الروح مشدودة للأسفل أكثر من الأعلى، فهكذا “إن بؤسنا هذا وبشكل متكرر لا يترك لنا المجال للتعرف إلى العطية الإلهية، فالحركات اللحمية تستر وتغطي جمال الصورة”. “عندما يوظف أحدٌ ما كل قواه الروحية في الميول السيئة ويضع عقله في خدمتها، يجري فيه انقلابٌ في “صورة الله” إلى تلك الصورة البشعة، فكل طبيعتنا البشرية تُبنى على هذا الشكل، فيصبح العقل وكأنه لا يعمل إلا بحسب الميول السيئة ويجعلها تثمر بكثرة، فيعمل سخافات كثيرة لأنه وضع نفسه في خدمة ميوله السيئة”.
إن إشراق “صورة الله” أو تعتيمها أو تشويشها يعود إلى الإنسان، إلى حرية مبادرته، وإلى قراراته. لكن لا يمكنه التصرف حسب متطلبات “صورة الله” بقدرته الذاتية. لهذا السبب فإن الله أرسل له ابنه يسوع المسيح لينجده. ولقد أظهر المسيح للبشرية كيف يجب أن تسلك لتحقق “صورة الله” وأعطاها الوسائل لتفعله. المسيحي هو الإنسان الذي يجتهد لكي يصل إلى تحقيقٍ كامل لـ “صورة الله” من خلال السير على منوال يسوع المسيح وتقليده: “لكي نعطي تحديد للمسيحية قال أحدهم: أؤكد أن المسيحية هي تقليد للطبيعة الإلهية”.
إن الأمر المهم والأصيل في تعليم النيسي حول “صورة الله” هو في الدور المعطى للحرية. إنها تشكل للنيسي المظهر الأكثر بروزاً في شبه الإنسان لله: “إن الاستقلال وتقرير المصير هي من خصائص الطوباوية الإلهية؛ وبسبب حريته فإن الإنسان مساوٍ لله”. لكن النيسي يعرف جيداً أن الإنسان يمكن أن يسيء استعمال الحرية وأنه يمكنها أن تُستخدم لخراب “صورة الله”. لذلك ليس أي استعمال للحرية يجعل الإنسان شبيهاً بالله، إنما فقط الاستعمال الذي يبقى فيه الإنسان خاضع لله. إن الخضوع لله لا يلغي الحرية، لأنه تعبير عن حالتنا المنتمية جوهرياً إلى الله. فخدمة الله لا تقلل من قيمة الإنسان كما يكون في خدمة إنسان آخر، بل بالعكس ففيها كمال الإنسان.
الإنسان بحسب مار افرام السرياني (305-373):
إن طبيعة فكر وكتابات افرام غير خاضعة للتأثير الفلسفي الهليني، ففي شخصه لدينا تعبير ذو هوية سامية عن دين سامي. وفي الحقيقة ليس هناك فاصل حاسم بين التعبير السامي عن المسيحية وبين ذلك الصادر من معاصري افرام الذين كتبوا باليونانية أو اللاتينية. فلليونان طريقة فلسفية وتحليلية أما مار أفرام والمؤلفين السريان الأوائل فطريقتهم بشكل رئيسي رمزية وإبداعية تتبع نصوص الكتاب المقدس ذاتها. والفرق بين التقليدين ليس هو مفهومهما للنقاط الأساسية للعقائد المسيحية بقدر ما هو طريقة عرضهم المختلفة لهذه العقائد.
بالنسبة لموضوع الإنسان، فإن مار افرام يدرك دوماً أن هناك حد فاصل بين الخالق والمخلوق. فهو يتحدث عن الفجوة الوجودية بينهما، ولا يمكن للمخلوق أن يصل إلى الخالق. وهذا يعني أن “الطبائع” المخلوقة عاجزة عن أن تقول شيئاً عن الطبيعة الإلهية.
أمّا بالنسبة إلى قيمة الجسد فهو يتخذ موقفاً بعيداً عن الميول الأفلاطونية أو الثنائية، التي امتازت بها بعض اتجاهات المسيحية في بداياتها، والتي كانت تسعى للنيل من قيمة الجسد. إن موقفه الإيجابي نابعٌ من أن الجسد هو جزء من خليقة الله وعليه فينبغي ألا يتعرض للاحتقار، فكم بالأحرى ألا ينظر إليه على أنه شرير. وهكذا فإن الجسد والنفس متساويان في الأهمية في نظر افرام، ولكل منهما دور مختلف ليقوم به: “الجسد يرفع لك الحمد لأنك خلقته مسكناً لك، النفس تسجد لك لأنك خطبتها عند مجيئك” (في الهرطقات 17/5). وهكذا فإن الجسد يقدم نفسه خدراً تلقى فيه العروس، أي النفس، العريس السماوي.
المعرفة المكتسبة محايدة بحد ذاتها، لكن حين تُكتَسَب عن طمع وعجرفة، تنقلبُ مُرَّة وحتى ضارة؛ وهي مفيدة فقط في حالة الطاعة الكلية للوصية الإلهية. وهكذا بالنسبة لأفرام، فقد استمسكت البشرية بالألوهية مدفوعة بالعجرفة، ولهذا السبب بالذات خسرت مكافأة الألوهية التي كان الله يريدها لها فيما لو كانت قد مارست حرية الإرادة بالشكل الصحيح.
إن الهوة الوجودية بين الخالق والمخلوق محفوظة دوماً، وكان الله قد خلق آدم مع الإمكانية أن يصبح “إلهاً مخلوقاً”، والألوهية التي وُضِعَت في متناول البشرية هي، بالنسبة لأفرام، الحصول على الخلود والمعرفة المعصومة عن الخطأ. إن عقيدة التأليه، كما يفهمها أفرام، هي وسيلة فقط لتوضيح المعنى من أن يصبح البشر “أولاداً لله”، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في اللغات السامية قد تتضمن عبارة “ابن فلان” معنى “المشاركة في صفات كذا”، أو “يخص فئة كذا”.
إن عقيدة التأليه عند افرام ليست نتيجة “لسم اليونان الوثنيين” (أي الفلسفة) إطلاقاً. فجذورها راسخة متأصلة في تفسيره لقصة الفردوس وإدراكه لكامل غاية وأهداف التجسد. ويعطي لنا وضع التعبيرين المحكمين التاليين لهذه العقيدة جنباً إلى جنب ختاماً مناسباً لمناقشتنا لهذا الموضوع. الأول معروف جيداً وهو للقديس اثناسيوس: “أصبح الله إنساناً لكي يتمكن الإنسان أن يصبح إلهاً”؛ والثانية من أناشيد مار افرام: “أعطانا اللاهوت، أعطيناه الناسوت” (في الإيمان 5/17)، وهو لا يختلف أبداً في مضمونه الأساسي عن قول اثناسيوس.
خاتمة:
إن التغير المتواصل الذي طرأ على حياة الإنسان المعاصر جعله يفقد الأمان والثبات الذي كان يميز حياته فيما سبق، بالإضافة إلى ظهور نظريات وتعاليم كثيرة تعيد النظر في كل ما بنته الإنسانية في حضاراتها السابقة، فأضاع إيمانه وفقد معنى وجوده وجوهره. فمن الناس مَن وثق بإمكانيات الفرد الذاتية فقط ومنهم من وثق بإمكانيات البشرية في الحصول على معنى الوجود والحياة الإنسانية، ولكن هذين التّوجهين لم يعطيا أي تأكيد ومعنى لحياة الإنسان ووجوده إذا لم يكونا في انسجام مع الله. ففي الله يجد الإنسان والإنسانية المعنى الحقيقي للحياة. فالله خلق الإنسان على صورته كمثاله وجعل فيه الروح الخالدة لكي تدفعه وتوجهه إلى الله خالقها.
إن الإنسان صالح لأنه خُلِقَ على “صورة الله” كمثاله، فلا النفس سيئة ولا الجسد سيّء إنما ميول الإنسان السيئة وخضوعه لشهواته وطغيانها على فكره في كل نواحي حياته وإبعاد الله من حياته يجعل كل ما فيه موجه نحو السوء، وبالتالي تشويش “صورة الله” فيه فيصبح صورة بشعة، فتغدو معارفه وعلومه وروحه وجسده تبرز البشاعة وليس الجمال الذي خلقه عليه الله كصورة له.
لقد خلق الله الإنسان على صورته خالداً بالنفس ومميزاً بالمعرفة والحرية، لكن استعمال المعرفة والحرية التي أعطاه إياها الله بشكل متكبر ومتعجرف على الله، لن يوصله إلى التألّه الذي يسعى إليه، بل ليتألّه عليه أن يكون خاضعاً لله في كل شيء على مثال ابنه يسوع المسيح الذي تجسد ومات لأجلنا ليعيد لنا إمكانية التألّه فعندما تكون حياتنا على مثال حياته نصبح مؤلّهين “أبناء لله” بالابن يسوع.
لذلك فالله الآب يدعو الإنسان “صورته”، وكل إنسان لأن يكون ابناً له بابنه يسوع المسيح الذي افتدانا وخلصنا بدمه، فلنسمع صوته ينادينا ويدعونا لنشاركه في حياته الإلهية التي يريد أن يشركنا فيها منذ أن خَلَقَنا. فلنسمع صوت روحه القدوس يكلم روحنا ويذكّرنا بكل ما علمنا إياه الابن وننقاد له وهو يقودنا في “الطريق والحق والحياة”. لأن الحياة بالروح هي حركة مستمرة، إنها مشابهة لله والتوطّد فيه أكثر فأكثر، إنها عودة الابن إلى بيت الآب.

 منوعات
منوعات 

