قطار التربية السليمة
يسير على سكّتيّ المزيد والمحبّة البصيرة

يسير على سكّتيّ المزيد والمحبّة البصيرة
مواضيع تربوية
الأب سامي حلّاق اليسوعي
للجميع

بوجه عام، لا يعرف الإنسان عن نفسه إلاّ القليل. ومعرفته الناقصة لذاته تجعله يسعى إلى غاية محدودة. حين يبلغها يكفّ عن التطوّر مدّعياً أنّه لا يستطيع أن يكون غير ذلك. لكنّنا نرفض هذا المبدأ، ونحثّ المتربّين عندنا على “المزيد”. ونقصد بكلمة “المزيد” تلك الحركات المستمرّة في انطلاقة مندفعة مستديمة بلا كلل ولا ملل، من أجل تمجيد الله وخدمة البشر بازدياد لا حدّ له. فالمزيد مسيرة نحو الأفق. يتقدّم فيها المرء نحوه باستمرار دون أن يبلغه. وفي أثناء تقدّمه، يكتشف كم لديه من طاقات وإمكانات دفينة كان يجهلها.
أمّا “المحبّة البصيرة”، فهي القدرة على حبّ الأشياء باعتدال ومنطقيّة، والتعامل معها بوعي. بالمحبّة البصيرة يستطيع المرء أن يختار ما هو أفضل بالنسبة إليه في هذا الوضع وبموجب هذه الظروف وبمقتضى هذه الأحوال. ويغيّر اختياراته مع تغيّر تلك العناصر أو بعضها. ويفرض اتّباع أسلوب “المحبّة البصيرة” علينا ألاّ نحتمي وراء القانون أو القرار، بل أن نستثني بعض الأشخاص نظراً إلى أوضاعهم وظروفهم، حتّى وإن بدا الأمر للعامّة سلوكاً مستهجناً نفضّل فيه أناساً على آخرين.
إنّنا نسعى، في جوّ من “المحبّة البصيرة”، إلى ضبط المندفعين وحثّ البليدين وإثارتهم. وهذا يضفي على عمليّتنا التربويّة ديناميكيّة خاصّة، ويحثّنا على تطبيقها بأسلوب شخصيّ. فـ”المزيد” هدفنا، و “المحبّة البصيرة” وسيلتنا. لأنّ المزيد يجمع بين ما هو مطلق ونسبيّ. مطلقيّة الهدف ونسبيّة تحقيقه. أمّا “المحبّة البصيرة” فتجمع بين ما هو نسبيّ ومطلق. نسبيّة الوسائل المستخدمة ومطلقيّة السعي في سبيل “المزيد”. وهكذا، يستمدّ “المزيد” من “المحبّة البصيرة” روح المحبّة الّتي تحرّك العمليّة التربويّة وتلهمها، وتستقي “المحبّة البصيرة” من “المزيد” حيويّته وسعيه الدؤوب نحو ما هو أفضل وأعظم وأثمن. وحقيقة نهجنا التربويّ تكمن في تفاعل هذين القطبين وتضافرهما وتوحيدهما جدليّاً: لا “المزيد” وحده، ولا “المحبّة البصيرة” وحدها، بل كلاهما في آن واحد.
يتعلّق “المزيد” بما هو شموليّ ومجرّد. و “المحبّة البصيرة” بما هو خاصّ وواقعيّ. لذلك تتميّز تربيتنا في أنّها شاملة/واقعيّة كما أنّها مطلقة/نسبيّة. ويرتبط “المزيد” بالمثل العليا الّتي تدفع إلى الأمام وتحثّ على التقدّم. إنّه انطلاقة الحرّيّة نحو الآفاق الشاسعة. أمّا “المحبّة البصيرة” فترتبط بالواقع. إنّها الجهد والعناء. فلولا “المزيد” لانغمست التربية في رتابة الواقع. ولولا “المحبّة البصيرة”، لهربت التربية من الواقع.
“المزيد” هو الهدف. به يتجاوز الشخص محدوديّته. أمّا “المحبّة البصيرة” فهي الوسيلة، بها تميّز الوسائل والأساليب الملائمة للسعي إلى ذلك الهدف. إنّها تحقّقه بما يتلاءم وظروف الشخص والمكان والزمان. ويرتبط “المزيد” بالتربية في حدّ ذاتها، وبأهدافها العامّة للجميع. أمّا “المحبّة البصيرة” فترتبط بأساليب التربية المكيّفة لتناسب الشخص في بيئته وبحسب كيانه. لهذا السبب، نسعى في عمليّتنا التربويّة إلى إبراز “المزيد” تارة و “المحبّة البصيرة” طوراً، ونسعى إلى الجمع بينهما، مدركين صعوبة الوصول إلى التوازن الكامل بينهما. فقد يدفعنا طبعنا إلى “المزيد” أكثر منه إلى “المحبّة البصيرة” أو العكس. غير أنّ فعلنا التربويّ محاولة مستمرّة لجمعهما في توازن يسعى – وإن لن يصل – إلى الكمال.
قابليّة التقدّم والنموّ:
إنّ روح “المزيد” تفترض أن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ كلّ شخص قابل للتقدّم والنموّ باستمرار، وقادر على تجاوز ذاته بلا حدود. ويعود ذلك إلى أنّه شخص خاضع للزمان الّذي هو تقدّم ونموّ دائمان. لذلك علينا احترام مراحل تطوّره والوقت اللازم لها. فنتمهّل مع هذا ونسرع مع ذاك، كلّ بحسب ما هو عليه وما هو قادر عليه، في محبّة بصيرة وصبر وطول أناة.
ولا يحرّكنا في سلوكنا التربويّ هذا أمل بشريّ بل رجاء روحيّ. ففي كثير من الأحيان، نصاب بخيبة أمل ونيأس أمام أشخاص صعبيّ المراس، عاجزين عن أيّ تغيّر. لكنّ الرجاء المسيحيّ يذكّرنا بأنّ كلّ شخص يحمل في طيّات نفسه قابليّة للتأثّر، واستعداداً للتغيير، ورغبة في التقدّم، واشتياقاً إلى النموّ، حتّى وإن دلّت المظاهر الخارجيّة على عكس ذلك. وأساس رجائنا هو أنّ الله يعمل في الشخص أكثر ممّا نعمل نحن. وكما يقول القدّيس بولُس: “أنا غرستُ وأبُلُّس سقى ولكنّ الله هو الّذي أنمى.
فليس الغارس بشيء ولا الساقي، بل ذاك الّذي ينمّي وهو الله” (1كورنثس 3/6-7).
خلاصة القول، إنّنا نؤمن بأنّ كلّ شخص هو حرّ/ فريد/ قابل للتقدّم والنموّ. وهذا يجعلنا نثق بالمتربّي ثقة تحرّكها “المحبّة البصيرة”. إنّها ثقة لا تتجاهل الصعاب والعراقيل الّتي تعيق حرّيّة المتربّي وفرادته وتقدّمه ونموّه، بل تؤمن بأنّه قادر على تجاوزها بروح المزيد. وعلى أساس تلك الثلاثيّة، نحدّد طبيعة تعاملنا مع المتربّي. فنسعى إلى اكتشاف الإمكانات الكامنة فيه ونساعده على اكتشافها من أجل “المزيد”. وكذلك الحدود الّتي تعرقل مسيرته، فنسعى إلى تربيته تربية شاملة “بمحبّة بصيرة”.
الإمكانات والحدود من أجل تربية شاملة:
إنّنا نشجّع الّذين يتربّون عندنا ونحثّهم وندفعهم ونحمّسهم كي يكتشف كلّ واحد منهم غناه الشخصيّ وديناميكيّته الداخليّة ورغباته العميقة وتطلّعاته الطموحة. ونعرض على كلّ واحد قيماً ومُثُلاً عليا لتحقيق ذلك. ونسعى إلى أن نكون مثلاً لهم في التضحية والفرح الداخليّ والانشراح والمحبّة وحبّ الاكتشاف والفطنة … أي بالسعي إلى “المزيد”. كما نتمسّك بأهداب “المحبّة البصيرة”. وكم مرّة أصابتنا الدهشة حين اكتشفنا الإمكانات الدفينة أو الظاهرة عند المتربّي، فسعينا إلى أن نرافقه في مسيرته بمحبّة أخويّة.
إنّنا نساعد الشخص أيضاً على اكتشاف حدوده الّتي تعيق تقدّمه، وعلى الإقرار بها وقبولها إن لم يكن باستطاعته تخطّيها. ومن الحدود الثقيلة الوطأة ماضي الشخص وطباعه وعلاقاته وظروفه … فالإقرار بها يساعده على التآلف معها لأنّه، كما يقول بعض الفلاسفة الوجوديّين، “ما من حرّيّة مطلقة في العالم، فجميع الحرّيّات مشروطة”.
علاقة المربّي بالمتربّي:
تكوين العقل
إنَّ سعينا إلى كشف الإمكانات والحدود عند الشخص يصبو إلى تربيته تربية شاملة: الذاكرة والعقل والإرادة والحرّيّة والضمير والأفكار والأقوال والأفعال والمخيّلة والحواس والجسد والوجدان والمحبّة. وأهمّ هذه الأمور ثلاثة نعدّها بالترتيب: العقل/ الإرادة والوجدان/ المحبّة.
شعارنا في تكوين العقل هو التالي: “إنّ ما يُرضي النفس ويشبعها ليس العلم بغزارة وإنّما الشعور بالأشياء والتذوّق الباطنيّ لها”. لذلك لا نرمي، في عمليّتنا التربويّة، إلى التثقيف بقدر ما نرمي إلى التكوين. فعلى المتربّي ألاّ يتعلّم كثيراً. لأنّ هذا يجعله يحشو المعلومات في رأسه حشواً بأسلوب الحفظ الغيبيّ من دون تفكير. بل عليه أن ينمّي قواه العقليّة، بحيث يسمو في عقله إلى أقصى حدّ من النموّ، وأن يزيد من مستواه الثقافيّ ويُسَرّ بالمعرفة والحكمة في الحياة والرغبة في الله.
تكوين العقل:
حين أدخِلَ المسرح والنشاطات الفنّيّة في أنشطة التعليم. أثيرَت انتقادات كثيرة. فقال الناس إنّ المربّي، بدل أن يدرّب المتربّين على تذوّق الله وإغناء المعارف، لا يسعى إلاّ إلى التدريب على الذوق السليم والعادات الجميلة، شأنه في ذلك شأن أساتذة آداب الحياة الاجتماعيّة. ولازال بعض الأشخاص، حتّى من بين المربّين، يعتبرون النشاطات الفنّيّة والرياضيّة أموراً لا تمسّ للعمليّة التربويّة بصِلة. فهم يفهمون العمليّة التربويّة كعمليّة تعليميّة صرفة، ولا يليق بهيئة تربويّة تعليميّة أن تنظّمها، وهي مضيعة لوقت الأولاد. إنّهم يستهجنون أيضاً كلّ نشاط جسديّ أو ترفيهيّ أو فنّيّ، ويعدّونه مضيعة للوقت، لأنّ الطفل أو الشابّ في رأيهم هو مجرّد “آلة للدرس وتحصيل العلامات”. وكلّ ما خرج عن ذلك فهو من الشرّير.
إنّ موقفنا واضح لا يحتمل الالتباس. إن أردنا العمل من أجل مجد الله، لا يكفينا أن نعلن البشارة ونمنح الأسرار، بل علينا، تحت طائلة عدم الأمانة، أن نهتمّ بكلّ الإنسان، وبكلّ ما يمتّ إليه في حساسيّته ومخيّلته وعاطفته وطموحه وسعيه ومواهبه ونظرته إلى الجمال والحق. لذا، يجب على المربّي أن يستند إلى جميع إمكانات المتربّي ليساعده على أن يصبح إنساناً بكلّ ما في الكلمة من معنى. فلا يقوم دوره على تعليم الجاهل وتثقيفه ليصبح إنساناً مثقّفاً، بل على مساعدته في التقدّم بحسب مبدأ “المزيد” نحو الحقّ وفي الاكتمال إلى أبعد حد. ويتجلّى هذا الأمر في أسلوبنا التربويّ. فنحن لا نشرح كلّ النصوص حول موضوع معيّن، بل نكتفي بقراءة نصٍّ واحد، وهو ما نسمّيه “القراءة التمهيديّة”، وندرّب المتربّي على فنّ التعمّق في فكرة كاتبه وأسلوب تأمّله واستخراج كنوزه، بحيث يصبح قادراً على التفكير والتأمّل والاستنتاج أمام أيّ نصّ يقع بين يديه، سواء كان دينيّاً أو عاديّاً. وبأسلوبنا هذا نعلن عداءنا لحشو الرؤوس.
ثلاثة مبادئ لتكوين العقل: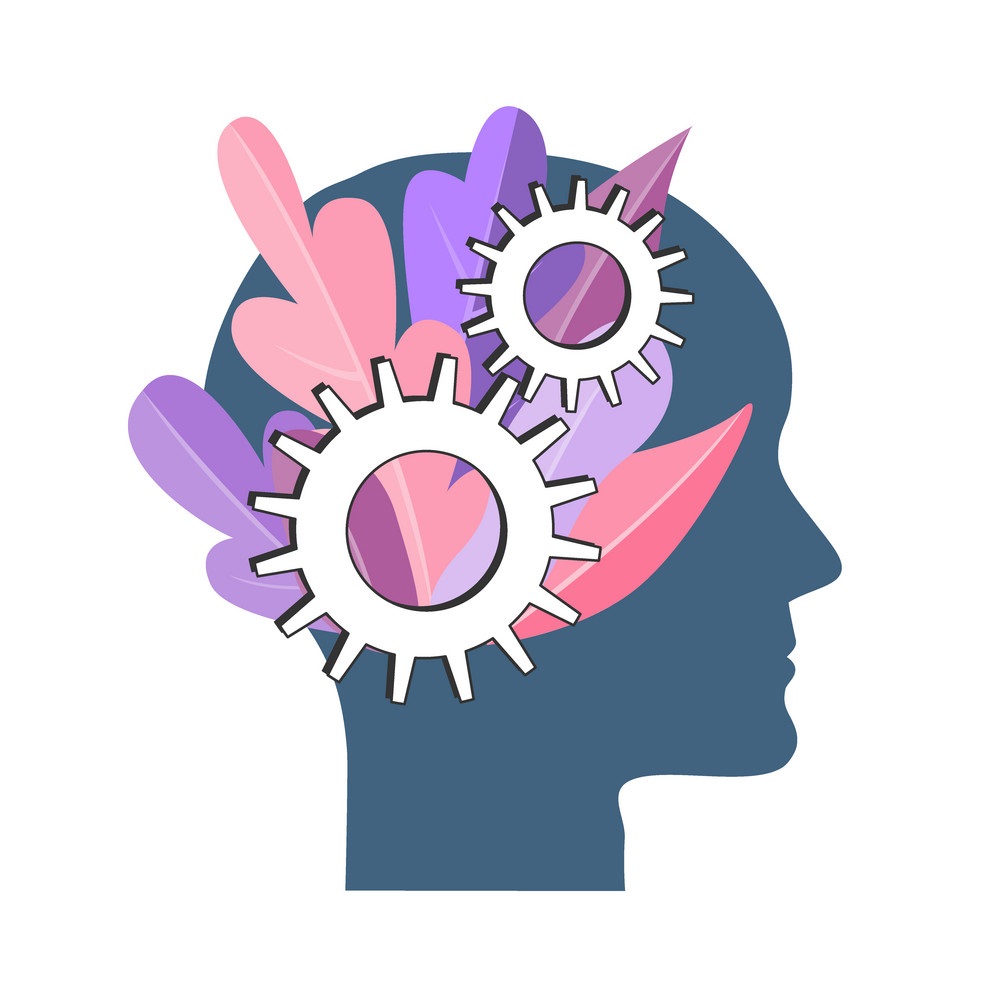
تُختصر مبادئنا لتكوين العقل في نقاط ثلاث:
على هذا الأساس، يلتزم المربّي بالأمرين التاليين:
لهذا لا نُملِ الدروس إلاّ بعد مناقشتها ثمّ شرحها. ولا يهم إن كتّبنا الطالب كلّ شيء قلناه أم لا. فالإملاء يضيّع على المربّي فرصة عرض التفكير النقديّ (لا الانتقاديّ). وبدل أن يجد المتربّي ماءً لا ينال إلاّ الوحل. فالكتابة عمل كاذب، والوقت الّذي تستغرقه وقت ضائع، لأنّه يمكننا أن نجد ما ندوّنه في كتب تعرضه بأسلوب أفضل من دفاترنا.
يقوم المربّي بطرح الأسئلة بحسب طريقة سقراط كي يثير اهتمام المتربّي ونشاطه. فلا تُطرح الأسئلة لمراقبة معلومات المتربّي أو لامتحان ذاكرته، لأنّ هذا لا يتطلّب من المتربّي أيّ مجهود عقليّ ولا يكوّن العقل. فحمل الطالب على التفكير يختلف عن تسميع الدروس. وهناك فرق شاسع بين الفاحص الّذي يحمل الطالب على أن يقول ما يعرفه، والمربّي الّذي يسعى إلى مساعدة عقله، المغشّى بالغوامض، على اكتشاف ما يظنّ أنّه يجهله أو ما يفكّر فيه تفكيراً غامضاً. فعلى سبيل المثال، إذا كان الدرس عن الشر، يسأل المربّي:
إنّه كلّ عملٍ سيّء يقوم به الإنسان وكلّ كارثةٍ طبيعيّة تؤذيه.
إذا كان الجواب “الله”، نسأل مباشرة، إذا كان الله هو الّذي صنع الشرّ فهو شرّير! وإذا كان الجواب “الشيطان”، نسأل، وهل الشيطان خالق ليخلق الشر؟ وهكذا، يبدأ المتربّي بالتفكير.
ويرافق التمرين الشفهيّ في طرح الأسئلة تمارين أخرى خطّيّة متنوّعة إلى أقصى حدّ في التأليف، ممّا يفسح المجال لقوّة الإبداع عند المتربّي. ففنّ التأليف يضع المتربّي في صلة حميميّة بالمجهود الإبداعيّ الّذي قام به المؤلِّف، في حين أنّ الإلقاء، ولا سيّما التمثيل، يمكّنانه من الانفتاح على الشعور بالجمال. ففي التمثيل يعبّر المتربّي بصوته وحركاته ومواقفه وحساسيّة جسده عن الأفكار والمشاعر الّتي وجدها في النصّ. لهذا نعير التمثيل اهتماماً بالغاً.
أمّا المبدأ الثالث لأسلوبنا التربويّ لتكوين العقل فهو المراجعة. على المربّي أن يخصّص قسماً كبيراً من اللقاء لتثبيت النتائج المكتسبة، والتحقّق ممّا اكتسبه الطلاّب. ولا تكون المراجعة تكراراً يتناول الذاكرة، بل عودة إلى الموضوع نفسه، ولكن من ناحية أكثر تآلفاً من الأولى. فبعد مناقشة نصّ ما، تُعاد قراءته، فيتمتّع المتربّي به، ويتذكّر جميع النقاشات الّتي دارت حوله. وفي المرّة التالية، يُحاول الطلاّب تذكّر ما قيل. والمراجعة تكشف للمربّي جدوى أسلوبه التعليميّ. بها يستطيع أن يدرك إلى أيّ درجة أصغى إليه المتربّي وفهم كلامه وحفظه واستوعبه، وأين يبدأ جهله وقلّة إدراكه. ولا ضير في أن يقضي المربّي في تدريب طلاّبه على التعبير ضعف الوقت الّذي كرّسه للتعليم(الدرس).
علاقة المربّي بالمتربّي:
تكوين الإرادة والوجدان
إنّ غاية تكوين الإرادة والوجدان هي تحويل المتربّي إلى إنسان حرّ واعٍ لأعماله. والحرّيّة في نظرنا هي التغلّب على أهواء النفس والطواعيّة الإراديّة لعمل النعمة. وهذا لا يتمّ بطريقة عفويّة، بل بتدريب مستمر على “التغلّب” على النفس، وعلى فرض نظام يُخضع جميع قوى الإنسان لقدرة عُليا. فنحن لا نفرض أنظمتنا من أجل الخير العام، بل من أجل تكوينٍ له هدف روحيّ ألا وهو اكتشاف الحرّيّة وممارستها.
تكوين الإرادة والوجدان:
لا يقتصر هدفنا في التربية على تكوين عقل المتربّي وحسب، بل يشمل تكوين إرادته أيضاً. أو بعبارة أدق، نحن نكوّن الإرادة بتكويننا للعقل. ودور المربّي هو شحذ العزيمة بقدر ما هو إيقاظ العقل. لذلك نسعى في أنشطتنا إلى تدعيم عنصر المغامرة، وعلى المتربّي أن يتعلّم كيف يواجه الصعوبة ويذلّلها من دون يأس. وهذا من شأنه أن يقوّي إرادة المتربّي ويجعله ينتصر على أعدائه الباطنيّين من ميول لا تفيده في بناء شخصيّته. ونعتمد في إثارة الهمم وإشعال روح الحماس على العلاقة بين المربّي والمتربّي. وقوامها الثقة المتبادلة والصراحة والفرح.
إنّنا نقوّي الإرادة والوجدان من خلال خلق شعور من الشرف عند المتربّي. ونرفض أسلوب العقاب الشرس. فالتوبيخ الكلاميّ المهذّب، الّذي يتمّ في جوّ من “المحبّة البصيرة”، يأتي بنتائج أفضل بكثير من العقاب. وكثيراً ما يعدّل المتربّي سلوكه بدافع الخجل لا الخوف. والشعور بالخجل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشعور بالشرف. أمّا العقاب، فيصطبغ على الدوام بصبغة الخدمة. حين يقوم المتربّي بعمل سيّء، نعاقبه بأن نطلب منه أن يقوم بعملٍ حسن للتكفير عن خطئه. وحين ينفّذ ما طلبناه منه، يشعر براحة التكفير وفخر العمل الصالح في آنٍ واحد. وإذا يئسنا من مذنب، نفصله إلى حين كي يشعر بألم خطيئته من خلال ابتعاده عن المركز وما فيه من نشاطات وجوّ فرح.
ومن الوصايا الّتي نراعيها في القصاص نذكر ما يلي:
لا شكّ في أنّ هذه العمليّة شاقّة. فنحن نسعى إلى الجمع بين الحزم واللين. وهو أمر لا غنى لنا عنه للإيحاء بالثقة، ولكنّه شاقّ. فمن بين المربّين مَن يسعون إلى الكمال ولا يعيرون الضعف البشريّ انتباهاً. ومنهم مَن يميلون بإفراط إلى الشفقة فيشجّعون، بحجّة العطف، التراخي في الالتزام. فلا بدّ إذاً من أن يكون الحزم غير عنيف، واللين غير ضعيف.
ندرِّب الإرادة أيضاً بالتشديد على المجهود المبذول. فنطلب من المتربّي أن يقوم بإنجاز أعمالٍ في فترة محدّدة وبدقّة كي يتعلّم الإسراع في توظيف جميع قواه. ونعلّمه أنّ الجهد المبذول يؤدّي إلى نتائج ليست باطلة، لأنّ الإنسان يستطيع، في أيّ سنّ من عمره، أن يؤثّر في مصيره، مُعِدّاً إيّاه ومتكهّناً ببعض منعطفاته وراغباً فيه. ونحيي في المتربّي روح التفاؤل وحبّ العمل، وهما صفتان لا غنى عنهما للنجاح. ولعل التنافس خير مضمار لتقوية روح التفاؤل إن تمّ بأسلوب شريف وجوّ محبّة. بهذا الأسلوب يستطيع المتربّي أن يكون متفائلاً متشبّثاً يؤمن بقدرته وقيمة الجهد الّذي يبذله، وبالتالي، قويّ الإرادة، وشديد التصميم.
علاقة المربّي بالمتربّي:
التكوين على المحبّة
وفي التكوين على المحبّة، ننظّم حياة الأولاد على غرار مجتمع صغير. لكلّ واحد فيه حقوق وواجبات تجاه الآخرين. وعلى كلّ واحد أن يكون في مكانه بحسب قدرته وإمكاناته، وأن يكوِّنَ نفسه مجتهداً أن يبقى بمستوى الجماعة. وعلى المربّي المسؤول واجب الجمع بين تقدّم المجموعة وتقدّم كلّ عنصر فيها.
تكوين المحبّة:
يُختصَر شعار تكويننا للناس على المحبّة بالعبارة التالية: Men for others رجال من أجل الآخرين. إنّنا نربّي المتردّدين إلينا ضمن مجموعات. واجتماعنا بهم حوار أكثر منه درس. حوار بين المربّي والمتربّين، وبين المتربّين أنفسهم بإشراف المربّي. فإلى جانب نموّ كلّ واحد بمفرده، نسعى إلى نموّ المجموعة معاً من خلال عمل الفريق أو مشروع الفريق الجماعيّ. يشارك فيه كلّ واحد بحسب ما أعطاه الله من مواهب وإمكانات. فأولاد التعليم ليسوا أرقاماً بل شخصيّات مميّزة تمكّنهم الحياة الجماعيّة من تثبيت شخصيّتهم وإثبات كيانهم أمام الآخرين ومعهم.
ويُعدّ التنافس الشريف من الوسائل الّتي نستعملها لتقوية الروح الجماعيّة. ونحرص على ألاّ يتمّ بروح حسد، بل “بمحبّة بصيرة”. فالمنافس الحسود يرغب في التغلّب على الخصم ولا يبالي بتحسين نفسه، بل يكفيه أن يُذِلَّ الخصم بأيّة طريقة كانت. وهو لا يتمنّى تقدّم خصمه، بل يشمت بتدهوره. أمّا روح التنافس الشريف الّتي نسعى إلى تنميتها، فهي تقدّر الآخر وتشجّعه على التحدّي وتخطّي محدوديّته. هذه غايتنا من كلّ ما ننظّمه في المباريات بشتّى أنواعها: رياضيّة، ثقافيّة، معلوماتيّة … وإذا كنّا نضيف إلى كلمة “تنافس” لقب “الشريف” فلأنّنا نريد أن يتنافس أولادنا في الفضائل والروحيّات، كما يقول القدّيس بولس. بذلك نستطيع أن نروّض غريزة من أقوى غرائز الشباب، ألا وهي الصراع، ونطوّعها لنجعلها حليفاً لروح المحبّة لا خصماً.
لا شكّ أنّ التدرّب على روح التنافس الشريف صعب. لذا، نعتمد على المراجعة والتقييم بعد كلّ منافسة. ولا يتركّز تقييمنا مع المتربّين حول أسباب النجاح أو الخسارة، بل الروح الّتي خضنا بها المنافسة، وكيف أظهرت وجوه الخطيئة الكامنة في كلّ شخص. ففي المنافسة ينـزع المتربّي عن وجهه قناع التقويّات، ويُظهر كلّ ما فيه من عنف وضعف وأنانيّة وحسد وغضب … فيسهل على المربّي معرفته معرفة أفضل، ويسهل عليه هو أيضاً، من خلال المراجعة، معرفة نفسه على حقيقتها من دون رياء أو خداع. وبذلك يمكن للعمليّة التربويّة أن تأتي بثمر أفضل، لأنّها تنطلق حينذاك من الواقع وتعتمد على الصراحة. أمّا من جهة “المزيد” و “المحبّة البصيرة” فثمّة مناهج للتكوين على المحبّة وهي: التعاون وتكوين النخبة والحوار والنظام.
فمن جهة التعاون، نحن نعلم مدى قوّة الجماعة عندما تعمل معاً، ومدى فاعليّتها الّذي يفوق عمل فرد واحد وحيد، أو عمل مجموعة من الأفراد غير متّحدين فيما بينهم. ويُعتبر هذا المنهج ذا أهمّيّة كبيرة. فكثيراً ما تطغى بين المربّين أو بين المتربّين روح التواجد معاً على روح التعاون معهم والتضامن الحقيقيّ بينهم والخدمة المشتركة. وكثيراً ما تتغلّب الروح الاجتماعيّة على الروح الجماعيّة. أمّا روح التعاون والتضامن والخدمة، فهي في سبيل تمهيد الطريق للالتزام مع الفقراء وخدمتهم.
ومن جهة تكوين النخبة، نحن نعي أنّ المتردّدين إلى مراكزنا ينتمون إلى طوائف متنوّعة. ونعي في الآن نفسه معاناة الطوائف الّتي ينتمي هؤلاء إليها وفقرها. لذلك نبذل قصارى جهدنا في تكوينهم كي يفيدوا الآخرين في المستقبل كما استفادوا هم منّا. إنّنا نكوّن رسلاً تكويناً صالحاً كي يكونوا في مجتمعاتهم كالخمير في العجين، ويكونوا أداة للتغيير نحو الأفضل.
وفي منهج الحوار، نتبع القاعدة الذهبيّة ونربّي عليها: على الإنسان أن يفترض صحّة رأي الآخر وحسن نيّته. فيجب على المتربّين عندنا أن يبرّروا فكرة الآخر وسلوكه لا الحكم عليه. فإن تعذّر عليهم ذلك، فليسألوه. وإن كان في أفكاره أو سلوكه ما هو غير صحيح، فليُصحّح بمحبّة. إنّه منهجنا للتحاور مع الناس، بحيث يتدرّب المتربّي على بذل قصارى جهده للحوار مع الآخرين، لا في أثناء تكوينه فحسب، بل في حياته المستقبليّة أيضاً، حيث يواجه حتماً أشخاصاً وجماعات، آراء ونظريّات، نظماً ومؤسّسات … لا يتّفق دوماً معها، وعليه رغم ذلك أن يتحاور معها.
أمّا التنظيم، فيعتمد على النمط السلطويّ أكثر منه على الديمقراطيّ. فالمرجعيّة الواحدة ضروريّة لتنسيق العمل وتوحيد التوجّه. إلاّ أنّ هذا لا يلغي الحوار المصغي بين الرئيس والمرؤوس. ونحن نشدّد كثيراً على النظام، لأنّه أسلوبنا الوحيد في تحقيق العدالة بين الأشخاص واحترام حقوقهم وتحرير الحرّيّات. فبالنظام نقوّض ما يعتري النفس من فردانيّة أو طغيان. إنّه السدّ الضروريّ لتنظيم تدفّق الماء بدل أن يكون سيلاً جارفاً تارة، ومستنقعاً عفناً تارة أخرى. غير أنّ المرونة ضروريّة مع الحزم، وذلك بمقتضى “المحبّة البصيرة”. فعلى النظام أن يتلاءم مع المتربّين، وعلى المسؤول الّذي يطبّقه أن يجمع بين “الحزم والحلم، والصرامة والوداعة. فلا يعدل عمّا يراه أكثر مرضاةً لله ربّنا، ولا ينقص ما يتوجّب عليه من حنان نحو أبنائه، حتّى يعترف الّذين وبّخهم أو عاقبهم بأنّه تصرّف باستقامة في الربّ وبأنّه عمل بدافع المحبّة، ولو جاء عمله مخالفاً لنـزعاتهم البشريّة”. باختصار، يعتمد تطبيق النظام على مقولة القدّيس بولس: “الحرف يميت، والروح يحيي” (2كورنثس 3/6). فبدون الحرف يصبح الروح واهناً، وبدون الروح يصبح الحرف قاتلاً.
الخاتمة:
إنّنا نصبو، من خلال عملنا التربويّ، إلى تكوين شخصيّة متّزنة. فلو كوّنّا التقوى فقط، لوقعنا في فخّ التقويّات، وأنتجنا أناساً حالمين بعيدين عن الواقع. ولو كوّنّا العقل فقط، لوقعنا في فخّ “العقلانيّة”، وأنتجنا شخصيّات متعصّبة متشبّثة بآرائها، واثقة ثقة عمياء بصحّة مواقفها، ولا تأخذ بعين الاعتبار محدوديّة الآخرين أو ضعفهم. ولو كوّنّا الوجدان فقط، لوقعنا في فخّ الإشراق، وأنتجنا شخصيّات لا تهتمّ إلاّ بنفسها.
الصورة النموذجيّة للتربية في مراكزنا هي تكوين القوى النفسيّة الثلاث بالتوازي: العقل والوجدان والإرادة.
بتكوين العقل، تصبح الشخصيّة قادرة على الفهم والتفكير والتحليل والاستنتاج والمقارنة والحكم والتطبيق، بروح النقد (لا الانتقاد) الّتي لا تسلّم تسليماً أعمى بما تسمعه أو حتّى تراه، بل تجتهد في فهم الأمور والقضايا وفي تكوين رأي شخصيّ، وتكون أمينة فكريّاً في معالجتها. شخصيّة منفتحة على كلّ ما يأتي من الخارج، من أشخاص وأحداث وآراء وتطوّر. ولا يتحقّق هذا إلاّ بالتدرّب على الدقّة والإتقان والكفاءة والإبداع والابتكار والتعلّم أكثر منه التعليم.
وبتكوين الوجدان، تستخدم الشخصيّة الوجدان استخداماً متّزناً بدون تطرّف، وتتذوّق الأشياء تذوّقاً باطنيّاً، وتنظر إلى الأمور بالعقل والقلب معاً، وتحرّكها الرغبات المضبوطة. شخصيّة مبنيّة على المحبّة الّتي قوامها العطاء المتبادل بين المحب والمحبوب، فتظهر في الأفعال أكثر منها في الأقوال، فتحب الله في كلّ شيء، وتحبّ كلّ شيء في الله.
وبتكوين الإرادة، تستطيع الشخصيّة أن تضبط نفسها وتقاوم ميولها، وتحيا القيم والفضائل بضمير حيّ مستقيم، وتتّخذ القرارات وتنفّذها وتلتزم بها، فتصبح شخصيّة حرّة لا يغريها النجاح ولا يحطّمها الإخفاق أو الشدّة.
وفي نهاية المطاف، نهدف من عملنا التربويّ إلى تكوين بشر من أجل الآخرين، فلا يحيا الشخص من أجل ذاته ولتحقيق مآربه الفرديّة، بل ينطلق نحو الخدمة. فالإحساس بالآخرين، والتضامن مع الفقراء، واحترام صغار الناس والمنبوذين، هي صفات الشخصيّة الّتي نريد تكوينها لدى المتربّين، كي يساهموا في بناء مجتمع جديد مبنيّ على قيم إنسانيّة متأصّلة في الإيمان بالله والثقة بالإنسان. مجتمع يتميّز تعامل بعض أفراده مع بعضهم الآخر بروح المزيد والمحبّة البصيرة. فبهذه الروح يستطيع المرء أن يميّز ما هو خير في مجتمعه لتنميته وما هو شرّ لإصلاحه. فيتمّ بذلك ما قاله القدّيس إيريناوس: “مجد الله هو الإنسان الحي. وحياة الإنسان هي رؤية الله”.
“مثالنا الأعلى هو إنسان مكوّن تكويناً حسناً، كفء فكريّاً، منفتح على التقدّم، روحانيّ، محبّ ملتزم في خدمة العدالة خدمة سخيّة” (الأب بيتر هانس كولفنباخ اليسوعي).

 من أمراض سوء التربية
من أمراض سوء التربية 

