انجيل الحياة Evangelium vitae
إرشاد رسولي

إرشاد رسولي
وثائق كنسيّة
البابا القديس يوحنا بولس الثاني
إلى الكنيسة جمعاء
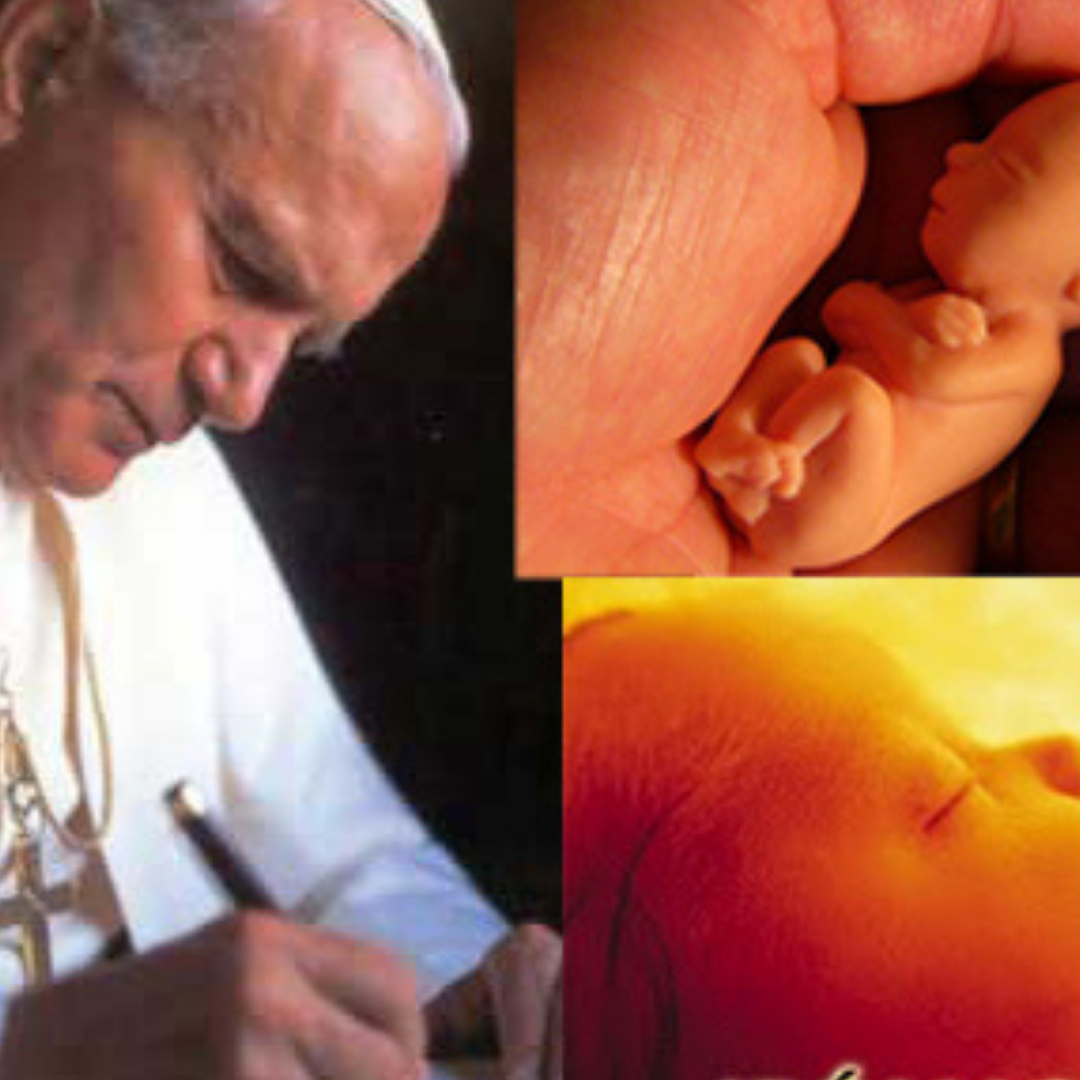
مقدمة
1- إنجيل الحياة هو في صميم الدعوة التي نادى بها يسوع، وتتلقاه الكنيسة كل يوم بحب لتذيعه بجرأة وأمانةٍ بشرى جديدة لجميع الناس من كل عصر وكل ثقافة.
في فجر الخلاص تمّ ميلاد طفل أُعلِنَ للناس نبأً سعيداً: “إني أبشركم بفرح عظيم يعمّ الشعب بأجمعه: ولد لكم اليوم مخلّص في مدينة داود، وهو المسيح الرب” (لو2/ 10- 11). لا شك أن ولادة المخلّص قد أتاحت “فرحاً عظيماً” ولكن، في الميلاد، انكشف أيضاً كلُّ مولدٍ بشري في كنهه التام، فظهر الفرح الماسيحاني ركيزةً وإكليلاً للفرح الذي يرافق مولد كل طفل (يو 16/ 21).
وقد عبّر يسوع عن فحوى رسالته الفادية بقوله: “لقد جئتُ لتحيا الخراف وتفيض فيها الحياة” (يو 10 / 10). والواقع أنه كان يتحدَّث عن الحياة “الجديدة” و”الأبدية”، وهي حياة الشركة مع الآب يُدعى إليها كل إنسان بالنعمة في الابن وفعل الروح الذي يقدّسنا. ففي هذه “الحياة الأبدية” تكتسب حياة الإنسان في كل وجوهها وظروفها ملء معناها.
الشخص البشري وقيمته الخارقة
2- الإنسان مدعوّ إلى حياة زاخرة تتخطّى حدود وجوده على الأرض لكونها اشتراكاً في حياة الله ذاتها.
هذه الدعوة التي تفوق الطبيعة تكشف، بعمقها، عظمة الحياة البشرية وقيمتها حتى في طورها الزمني. ولا شك أن الحياة، في تضاعيف هذا الزمن، هي شرط أساسي ومرحلة ابتدائية وجزء لا يتجزأ من الوجود البشري في تطوّره الكامل والمترابط. هذا التطوّر في مسيرة الحياة يستنير، على غير انتظار وغير استحقاق، بوعد الحياة الأبدية، ويتجدّد بموهبة هذه الحياة الإلهية، إلى أن يبلغ إلى ملء تمامه في الأبدية (1يو3/ 21). هذه الدعوة الفائقة الطبيعة تُظهر، في الوقت نفسه، ما يميّز حياة الرجل والمرأة على هذه الأرض من طابع نسبي. والحقيقة أن هذه الحياة ليست هي “الأخيرة” بل ما قبل الأخيرة. وهي، على كل حال، حقيقة مقدسة وُكِلَت إلينا لنصونها بطريقة مسؤولة، ونفضي بها إلى كمالها في الحب وبذل الذات لله وللآخرين.
وتعلّم الكنيسة أن إنجيل الحياة هذا الذي تسلَّمَتْه من الرب (1)، يلقى صدىً عميقاً ومقنعاً في قلب كل إنسان، أمؤمناً كان أم غير مؤمن، لأنه يتخطى ترقباته تخطياً لا حدود له، ويلبّيها تلبية مذهلة. وبالرغم من المصاعب والريب، بإمكان كل إنسان منفتح على الحقيقة والخير انفتاحاً مخلصاً، وبنور العقل وعمل النعمة الباطن، أن يتوصل إلى أن يكتشف في الشريعة الطبيعيّة المكتوبة في القلوب (روم2/ 14- 15) ما تتضمنه الحياة البشرية من قيمة مقدسة، من بدايتها حتى نهايتها، وبإمكانه أيضاً أن يؤكّد ما يتمتّع به كل كائن بشريّ من حقٍّ في أن يظل هذا الخير الأساسي في نظره موضوع احترام كامل. وحتى التعايش الإنساني والمجتمع السياسي يرتكزان على الاعتراف بهذا الحق.
الدفاع عن هذا الحق وإعلاء قيمته يجب أن يتحققا، بوجهٍ خاص، على يد المؤمنين بالمسيح الذين يدركون روعة الحقيقة التي ذكّر بها المجمع الفاتيكاني الثاني بقوله: “إن ابن الله بتأنسه قد اتحد، نوعاً ما، بكل إنسان (2). فالبشرية، من خلال هذا الحدث الخلاصي، لا تتلقى فقط الكشف عن حبّ الله اللامتناهي الذي “بلغ من حبّه للعالم أنه جاد بابنه الواحد” (يو 3/ 16)، بل أيضاً عما يتمتع به كل إنسان من قيمة لا تضاهى.
ولأنَّ الكنيسة لا تني تُنعِم النظر في سرّ التأنس فهي تتلقّى هذه القيمة بإعجابٍ متجدّد أبداً (3) وتشعر أنها مدعوّة إلى أن تعلن للناس، في كل الأزمان، هذا “الإنجيل”، ينبوع رجاءٍ غلاّب وفرح حقيقي لكل حقبة من حقب التاريخ. إنجيل حبّ الله للإنسان وإنجيل الكرامة البشرية وإنجيل الحياة: كلُّها إنجيل واحد لا يتجزأ. ولذا فالإنسان، الإنسان الحيّ، هو للكنيسة دربها الوحيد وطريقها الأساسي (4).
الأخطار الجديدة المتربّصة بالحياة البشريّة
3- بقوّة سرّ كلمة الله التجسّد (يو1/ 14) كل إنسان أصبح موكولاً إلى الكنيسة ومحبتها الوالديّة. ومن ثم، فكل ما يهدّد كرامة الإنسان وحياته لا يمكن إلاّ أن يمسَّ الكنيسة في صميم فؤادها ويصيبها في عُقر إيمانها بابن الله المتجسّد والفادي ورسالتها القاضية بنشر إنجيل الحياة في العالم كلِّه ولكل خلق (مر16/ 15).
هذه البشرى أصبحت اليوم على جانبٍ ملحوظ من الإلزام بسبب ما أمسى يهدّد الأفراد والشعوب من أخطار لا تزال تتكاثر وتتفاقم بصورة موجلة، ولا سيما إذا كانت هذه الحياة هشَّة عزلاء. وينضاف إلى الكوارث القديمة والمؤلمة، الناجمة من البؤس والجوع والأوبئة المستوطنة والعنف والحروب، كوارث أخرى بوجوهها الحديثة وأبعادها المقلقة.
في صفحة تتصف بالواقعيّة المأساويّة، ندّد المجمع الفاتيكاني الثاني تنديداً صارماً بالجرائم المتنوّعة والانتهاكات التي تستهدف الحياة البشريّة. بعد ثلاثين سنة، أودّ أن أتبنى هذه الكلمات المجمعيّة، وأندّد بهذه المساوئ مرّة أخرى وبنفس القوة، باسم الكنيسة جمعاء، واثقاً من أنني أترجم ما يشعر به بصدق كل ضمير مستقيم: “كل ما يتصدَّى للحياة ذاتها ككل ضرب من ضروب القتل والقتل الجماعي والإجهاض والقتل الرحيم وحتى الانتحار المتعمَّد، وكل ما هو انتهاك لحصانة الإنسان كالبتر والتعذيب الجسدي أو الأدبي ومحاولات الضغوط النفسانيّة، وكل ما يهين كرامة الإنسان كظروف الحياة المنحطَّة والاعتقالات الاعتباطية والنفي والرق والدعارة والمتاجرة بالنساء والأحداث، وظروف العمل المشينة التي تُحدِر العمّال إلى مستوى مجرّد أدوات للكسب، بلا حرمة لما يتمتعون به من شخصيّة حرّة ومسؤولة هذه الممارسات جميعها وما يشبهها إنما هي، في الحقيقة، ممارسات مخزية. فهي تفسد الحضارة علاوة على أنها تشين الذين يمارسونها أكثر مما تشين الذين يكابدونها وهي إهانة ثقيلة لكرامة الخالق” (5).
4- ومن دواعي الأسف أن هذه اللوحة المقلقة لا نراها تنحسر، بل نراها آخذة في الاتساع: فمع ما نلحظه من آفاق جديدة، ناجمة من التقدم العلمي والتقني، نرى أشكالاً جديدة من التعرّض لكرامة الإنسان. وفي الوقت نفسه ترتسم وتتكوّن حالة حضاريّة جديدة تضفي على الجرائم التي تستهدف الحياة وجهاً مستحدثاً وأكثر إغراقاً في الظلم – إن أمكن – وفي ذلك ما يبعث في النفس هموماً أخرى خطيرة: فثمة طبقات واسعة في الرأي العام تبرّر بعض الجرائم ضدّ الحياة باسم حقوق الحريّة الفرديّة، وتنطلق من هذه الأرضيّة لتطالب لا بالتبرئة وحسب بل بموافقة الدولة لتمارسها في حريّة مطلقة وبدعم مجاني من قِبَل الخدمات الصحيّة.
هذا كلّه يحد انقلاباً عميقاً في النظرة إلى الحياة والعلاقات بين الناس. فالتشريعات، في عدد كبير من البلدان، تنأى أحياناً عن المبادئ التي ترتكز عليها دساتيرها. فلا تكتفي بحجب العقوبة عن مستحقيها بل تقدم على الاعتراف بقانونية الممارسات ضد الحياة وشرعيتها الكاملة. هذا كلّه يشكل ظاهرة مُمِضَّة وسبباً لا يستهان به يؤدي إلى انهيار أدبي جسيم: ثمة خيارات كانت تُحسَب، في الأمس، جرائم يأباها الحسّ الأدبي العام، تصبح اليوم، في نظر المجتمع، جديرة بالاحترام شيئاً فشيئاً. وحتى الطب نفسه، المدعوّ إلى حماية الحياة البشريّة والعناية بها، ينساق أكثر فأكثر، في بعض القطاعات، إلى ارتكاب هذه الأفعال التي تستهدف الإنسان. وهو، بذلك، يشوّه صفحته ويناقض ذاته ويجرح كرامة الذين يمارسونه. في مثل هذه القرائن الثقافية والقانونية تمسي المعضلات الديموغرافية والاجتماعية والعيليّة الشائكة، التي تضغط على كثير من شعوب الأرض وتفرض تنبّهاً مسؤولاً وناشطاً على الجماعات الوطنية والدولية، معرّضةً لأن توجَد لها حلول زائفة وواهمة تناقض الحقيقة وتعارض خير الأفراد والشعوب.
إنها لمأساويّة النتيجة التي نفضي إليها: فلئن كان من الخطورة ودواعي القلق بمكان أن نلحظ الإجهاز على الآلاف من البشر البادئين في طريق الحياة أو المشرفين على نهايتها، فإنه ليس بأقلِّ خطراً ومدعاة إلى القلق أن نرى الضمير ذاته في شبه عماية من جراء خضوعه لمثل هذه التحوّلات العميقة وفي عجز متزايد عن التمييز بين الخير والشر في القضايا المتعلقة بالحياة البشريّة وقيمتها الأساسية.
في الشركة مع جميع أساقفة العالم
5- معضلة الأخطار المحدقة بالحياة البشرية في عصرنا كانت موضوع المجمع الاستثنائي للكرادلة الذي التأم في روما من 4 إلى 7 نيسان 1991. بعد بحثٍ مستفيض ومعمَّق في المعضلة وفي التحديّات التي باتت تستهدف الأسرة البشرية برمَّتها وبخاصة الجماعة المسيحية، طلب مني مجمع الكرادلة، باقتراع إجماعي، أن أؤكد ثانية، بسلطة خليفة بطرس، قيمة الحياة البشرية وحصانتها، في مواجهة الظروف الراهنة والتعديّات التي تهدِّدها اليوم.
لقد رحّبتُ بهذا الطلب، وفي عيد العنصرة من سنة 1991 وجّهت رسالة شخصية إلى كلٍّ من إخوتي في الأسقفية ليوافوني، في روح الجماعيّة الأسقفية، بقسطهم من التعاون لوضع وثيقة في هذه المسألة (6). وإني أشكر عميق الشكر لجميع الأساقفة أنهم استجابوا لطلبي وزوَّدوني بمعلومات وإيحاءات واقتراحات نفيسة. وبهذه الطريقة أيضاً أدّوا لي برهان مساهمتهم، بإجماع وصدق، في الرسالة التعليمية والرعوية التي تضطلع بها الكنيسة في قضية إنجيل الحياة.
في هذه الرسالة ذاتها، وقُبَيلَ الاحتفال باليوبيل المئوي للرسالة العامة في “الشؤون الحديثة”، لفتُّ انتباه الجميع إلى هذا الشبه الغريب: “كما أن الطبقة العمَّالية، منذ قرن، كانت هي المهضومة حقوقُها الأساسية، فتولَّت الكنيسة الدفاع عنها بكير من الجرأة وجاهرت بما يتمتع به العامل من حقوق مقدّسة، كذلك الآن، ونحن بإزاء فئة أخرى من الناس يُنتهك ما لها من حقّ أساسي على الحياة، تشعر الكنيسة بأن عليها أن تتسلح بنفس الجرأة وتعطي صوتاً لمن لا صوت له. إنها تستعيد دوماً صرخة الإنجيل في الدفاع عن بؤساء هذا العالم والمهدَّدين والمحتقرين والمحرومين حقوقهم الإنسانية” (7).
نحن نلاحظ اليوم جمهوراً من الضعفاء والعزَّل المهضوم حقُّهم الأساسي في الحياة، ومنهم خصوصاً الأولاد الموشكون أن يولدوا. فإذا كانت الكنيسة، في نهاية القرن السابق، لم يحقَّ لها أن تصمت عن المظالم القائمة آنذاك، فلا يحق لها اليوم أيضاً أن تصمت، وقد انضافت في غير جزءٍ من أجزاء العالم، إلى المظالم الاجتماعية السالفة التي لم تلقَ لها حلاً – حتى اليوم – مظالم وضغوط أشد خطراً، تُعتبر وسائل تقدم لإقامة نظام عمالي جديد؟
هذه الرسالة، وهي ثمرة تعاون الأساقفة في كل بلدان العالم، تود أن تكون تأكيداً مكرَّراً واضحاً وحازماً لقيمة الحياة البشرية وحصانتها، وفي الوقت نفسه، دعوةً لاهبة موجَّهة إلى الجميع وإلى كل فرد، باسم الله، أن: احترمْ وصُنْ وأحبِبْ واخدُمْ الحياة، وكل حياة بشرية! فعلى هذا الدرب فقط تلقى العدل والنموَ والحريّة الحقيقية والسلام والسعادة!
عسى أن تبلغ هذه الكلمات إلى كل أبناء وكل بنات الكنيسة! عساها أن تبلغ إلى الطيّبين الحريصين على خير كل رجلٍ وكل امرأة وعلى مصير المجتمع بأسره.
6- بعميق المشاركة مع كلٍ من إخوتي وأخواتي في الإيمان، وبدافع صداقة خالصة للجميع، أودّ أن أعود إلى “التمعن في إنجيل الحياة وأبشّر به سنىً” للحقيقة ينير الضمائر ونوراً ساطعاً يشفي الأبصار المظلمة، وينبوعاً لا ينضب من الثبات والشجاعة في مواجهة ما يعترضنا من تحديّات مستمرة.
وبينما أثوب بالفكر إلى الخبرات الثريّة التي عشناها خلال سنة العيلة، وبمثابة نتيجة للرسالة التي وجّهتها إلى “كل عيلة في كل أقطار الأرض” (8)، أرفع نظري، بثقة متجدّدة، إلى جميع العيل، متمنيّاً أن ينبعث ويتقوى، على جميع الأصعدة، تصميم الجميع على أن يدعموا العيلة لتستمرّ اليوم أيضاً – وسط مصاعب كثيرة وأخطار باهظة – وفيّة لقصد الله بان تكون “هيكلاً للحياة” (9).
إلى جميع أعضاء الكنيسة، وهم شعب الحياة المتجنّد للحياة، أوجّه ألحَّ نداءاتي لكي نتمكن معاً من أن نزوّد عالمنا بآيات جديدة للرجاء، باذلين جهدنا لإنماء العدالة والتضامن، وتدعيم حضارة جديدة للحياة البشرية وبناء مدنيّة صحيحة للحقيقة والحب.
تابع القراءة بتحميل الملف

 تألق الحقيقة Veritatis splendor
تألق الحقيقة Veritatis splendor 

